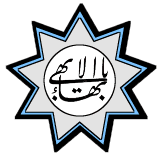دينُ الله وَاحِد
النظرَة البهَائيّة لمجتمعٍ عالميٍّ مُوحَّد
ترجمة: د. سهيل بشروئي
***
توطئة
في عيد الرضوان في عام ۲۰۰۲ وجَّهنا رسالةً مفتوحة إلى قادة الأديان في العالم كان مبعثُها إدراكنا أنّ آفة البغضاء والمشاحنات المذهبيَّة التي تهدد العالم بعواقب وخيمة لن ينجو منها إلاّ مناطق قليلة إذا لم يُكْبَح جماحها بشكلٍ حاسم. وسجَّلت رسالتنا تلك كلِّ التقدير لما أنجزته (حركة تآلف الأديان) التي سعى البهائيّون إلى الإسهام في دعم نشاطاتها في وقتٍ مبكر من ظهورها.
ومع ذلك شعرنا بأنّه لِزام علينا أن نتحدَّث بصراحة لنقول: إذا اقتضى الأمر معالجة الأزمة الدينية والمذهبية بالجدية التي تُعالَج بها العصبيات الأخرى التي يئنّ منها العالم الإنساني، فمن الضروري أنْ تجد النظم الدينية القائمة شجاعة مماثلة لديها لتسمو عاليًا، فتتخطى ما رسخ من مفاهيمٍ قديمة ورثتها من ماضٍ سحيق.
وعلاوةً على ذلك عبَّرنا عن اقتناعنا بأنّ الوقت قد حان لكي تواجه القيادات الدينية، بكلِّ صدقٍ ودون أدنى مراوغة، معنى الحقيقة القائلة إنّ الله واحد، وإنّ الدين أيضًا دينٌ واحد برغم تعدّد ما تصوغه الثقافات من تعابير وما يسهم به البشر من تفاسير.
وهذه الحقيقة هي التي أوحت أساسًا بقيام (حركة تآلف الأديان) ودعمت بقاءها برغم تقلبات الزمان مدة الأعوام المائة الماضية. فالإقرار بهذه الحقيقة بعيدٌ كل البعد عن أي تحدٍّ لصدق ما جاءت به الأديان المُنزَّلة، إذ باستطاعة مثل هذا الإقرار أنْ يضمن دوام تلك الأديان ويبِّرر ضرورة قيامها. ومن ناحيةٍ أخرى، إذا أردنا أنْ يكون للإقرار بحقيقة أنَّ الله إله واحد وأنّ الدين واحد، نتائج مؤثرة، فلابدَّ أن يكون الحوار الديني دائراً على أساس هذا الإقرار. وقد أملى علينا تداول مثل هذه الأفكار شعورًا بأنّ على رسالتنا تلك أنْ تكون واضحة كل الوضوح حيال هذا المفهوم عن الله والدين.
كان التجاوب مع رسالتنا تلك مشجّعًا. فكفلت الهيئات البهائية في العالم سُبُل إرسال الآلاف من نسخ تلك الرسالة، ليتسلَّمها أصحاب النفوذ من شخصيات الجامعات الدينية الكبرى. وإذ لم يكن مستغربًا أن ترفض بعض الدوائر الدينية فحوى تلك الرسالة رفضًا باتًا، ذكر البهائيون ممن لهم علاقة بالأمرأنّ الرسائل قد لاقت على وجه العموم ترحيبًا حارًا من متسلِّميها. ومن المؤثر خاصةً ذلك الإخلاص الجلي لدى العديد من هؤلاء. إذ عبَّروا عن حزنهم وآساهم لفشل المؤسسات الدينية في إعانة الإنسانية على مجابهة تحديات روحانية وأخلاقية في جوهرها. وسرعان ما دار نقاش بشأن الحاجة إلى تغيير جوهري لكيفية إقامة جماهير المؤمنين علاقتها بعضها ببعض. وفي حالات لا يستهان بها كان تأثير الرسالة على مستلِّميها من رجال الدين دافعًا لهم إلى استنساخها، وتوزيعها على أقرانهم المنتمين إلى طائفتهم. ويخالجنا شعور بالأمل أنّ مبادرتنا تلك كانت حافزًا لفتح الباب على مفهوم جديد للدين والغرض من وجوده.
وكيفما كان حدوث هذا التغيير، عاجلاً أم آجلاً، فإنّ اهتمام البهائيين يجب أنْ ينصب على مسئولياتهم تجاه هذه المسألة.
فلقد ألقى حضرة بهاء الله بالمهمة التي تضمن لرسالته اهتمام الناس بها في كلِّ مكان على عاتق أولئك الذين اعترفوا به. وكان هذا بالطبع ما شغل الجامعة البهائية طوال تاريخ الأمر الكريم، غير أنّ الانهيار المتسارع للنظام الاجتماعي القائم يطالب بإلحاحٍ شديد بتحرير الروح الدينية من تلك الأصفاد التي كبَّلتها ومنعتها من أنْ تجتذب ما هي قادرة عليه من تأثيرٍ شافِ للعلل.
وإذا كان للبهائيين أنْ يستجيبوا لحاجة العالم، عليهم أن يفهموا فهمًا عميقًا ذلك السَّياق الذي تتطور بموجبه حياة الجنس البشريّ الروحية.
وتتحفنا آثار حضرة بهاء الله الكتابية بنظرة ثاقبة تساعد على السموّ بمستوى النقاش بشأن القضايا الدينية فوق الاعتبارات المذهبية العابرة. أمّا مسئولية الاطلاع على هذا المصدر الروحي بالنسبة إلى كلِّ مؤمن فلا يمكن فصلها عن نعمة الإيمان ذاتها. وينذرنا حضرة بهاء الله قائلا ً: "إنّ التعصب الديني والبغضاء نارٌ تلتهم العالمَ ومن العسير إطفاؤها. ولا سبيل إلى إنقاذ البشرية من هذا البلاء العقيم إلاّ بيد القدرة الإلهية." [۱]
ويجدر بالبهائيين ألاّ يخالجهم الشعور بأنّهم من دون معين أو نصير في مساعيهم هذه لسدِّ ما تحتاجه البشرية اليوم، لأنّهم سوف يقدِّرون حق التقدير، وعلى نحوٍ مطّرد، أنّ الأمر الذي يقومون على خدمته هو بمنزلة رأس حربة ليقظة روحية عمَّت الناس في كلِّ مكان، أكانوا من خلفيات دينية أو ممن لا ميول دينية لهم.
وقد دفعتنا تأملاتنا في ما يواجه العالم من تحديات إلى تكليف هيئة خاصة أعدت تحت إشرافنا ما يأتي من الشرح والتعليق، وفي هذا التعليق بعنوان "دينُ الله واحد" عرضٌ لمقتطفات من كتابات حضرة بهاء الله ومن الكتب المقدّسة للأديان الأخرى، لها صلة وثيقة بخلفيات الأزمة الراهنة.
ونحن نوصي الأحباء بدرس هذا التعليقَ درسًا يتَّسم بالعمق والتفكير.
بيت العدل الأعظم
دينُ الله وَاحِد
كل المؤشّرات تدعونا إلى الثقة بأنَّ الحقبة التاريخية التي بدأ فجرها ينبثق الآن سوف يكون استعدادها للتجاوب مع الجهود المبذولة لنشر رسالة حضرة بهاء الله، أكبر ممّا كان عليه الحال في القرن المنصرم.
فالدلائل كلها تشير إلى أنّ تحولاً جوهريًا بالنسبة للوعي البشري بات الآن قائمًا على نحوٍ ناشط.
في باكورة القرن العشرين جاءت الفلسفة المادية بتفسير للحقيقة خاصٍّ بها. ورسخ في الأذهان هذا المفهوم المادي بصورةٍ تامة أصبح فيها كأنّه الدين العالمي المسيطر إلى حدٍّ ما على الاتجاهات التي يسلكها المجتمع. وضمن هذا السِّياق قد انتُزِعَتْ بكل عنف عوامل التربية الإنسانية من عوالمها التي عرفتها آلاف السنين.
فبالنسبة إلى معظم أهل الغرب كان المرجع الإلهي هو المصدر الرئيسي للهداية والرشاد برغم تفاوت التفاسير المتعلقة بطبيعة ذلك المرجع وجوهره، ولكنّ سرعان ما تلاشى كلُّ ذلك وفقد الغرب مرجعه الأصيل بكلِّ بساطة. فتُرِكَ الفرد إلى حدٍ ما بعيدًا حرًا ليتخذ لنفسه ما يعتقد أنّه الرابط بين حياته كفرد، وبين ذلك العالم الذي يتخطّى الحدود المادية للوجود. أمّا المجتمع بأسره فقد استمرَّ بثقة متزايدة، في تمزيق روابط اعتاده على مفهومٍ للكون اعتبره بعض الأشخاص في أفضل الحالات من صنع الخيال وفي أسوئها أفيونًا يتعاطاه الناس. وفي كلا الحالين شُلَّ التقدم وتعطَّل الرُّقيُّ، وهكذا تولّت الإنسانية زمام أمورها بيدها، إذ تبادر إلى أذهان الناس وصُوِّر لهم أنهم قد توصلوا بواسطة الاختبارات العلمية والحوار الفكري، إلى حلِّ جميع المعضلات المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بتطوير الإنسان وتدبير شئونه السياسية.
وقد دَعم هذا الموقف ذلك الافتراض القائل إنّ القيم والمُثل والضوابط الأخلاقية التي تعلمها الإنسان على مدى القرون، قد ترسَّخت الآن على نحوٍ يُعتمد عليه وأصبحت من مزايا الطبيعة الإنسانية الثابتة. وكلُّ ما احتاجته هذه المزايا هو مجرَّد صقلها عن طريق التربية والتعليم وتعزيزها بما يُشَرَّع من قوانين. فتُراث الماضي من الفضائل والأخلاق تلخَّص في ما يلي:
إن إرثَ الإنسانية الذي لا يمكن نقضه لم يعد بحاجة إلى أيِّ إسهام ديني لبقائه. وما لا يمكن إنكاره أنّ أفرادًا أو جماعات أو حتى أممًا من الخارجين على القانون والنظام سيستمرُّون في تهديد استقرار النظام الاجتماعي وسلامته، مما يدعو إلى تصحيح الأوضاع وضبط الأمور، فالحضارة العالمية التي سعت كلُّ قوى التاريخ إلى تحقيقها وقادت الجنس البشري نحوها، صارت تبرز إلى الوجود دون أنْ يعيقها عائق، وقد استمدت إلهامها من المفاهيم العلمانية للحقيقة. وهكذا بدت سعادة البشر كأنَّها نتيجة طبيعية لما تحقَّق من تحسُّن في مجالات الصحة والغذاء والتربية بالإضافة إلى تحسُّن ظروف الحياة والمعيشة، وأصبح كلُّ هذا الآن في متناول يد مجتمع إنساني تسيطر عليه فكرة واحدة تركَّزت في السعي إلى تحقيق مثل هذا التحسُّن وأهدافه التي لا ريب في أنَّها مستحبَّة ومطلوبة.
أمّا في ذلك الجزء من العالم حيث تقطن غالبية سكان الأرض، فلم يُعِرْ أحد من الناس اهتمام بذلك التصريح الأرعن الذي أعلن أنّ "الله قد مات" فالخبرات التي مرت بها شعوب أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ودول المحيط الهادي، والتي طالما أرسخت إيمانها بذلك الرأي القائل إنّ الطبيعة الإنسانية ليست فقط رهن المؤثرات الروحية، بل هي أيضًا ذات هويّة روحية في جوهرها، وكما كان الحال عليه دومًا استمر الدين نتيجة لذلك يؤدي وظيفته مرجعًا أخيرًا في حياة الناس. وفي حين أنّ الثورة الأيديولوجية الدائرة رحاها في الغرب لم تتصدَّ لتلك المعتقدات مباشرة، إلاّ أنَّها نجحت بالفعل في الإقلال من شأنها وتهميشها بالنسبة إلى تبادل العلاقات وتفاعلها بين الأمم والشعوب. ومن ثمَّ هبَّ المذهب المادي بعصبيته فغزا مراكز القوة والإعلام المهمة في الكرة الأرضية بأسرها واستولى عليها. وهكذا ضمن المذهب الماديّ لنفسه السيطرة الكاملة بحيث لم يعد في مقدور أيّة أصوات مناقشة الاعتراض على ما يقدِّمه من مشاريع اقتصادية استغلالية تستهدف العالم بأسره.
وعلاوة على ذلك فإنّ الأضرار الثقافية التي نجمت عن قيام حكم استعماري دام قرنين من الزمان، أضيف إليهما انفصام مرير أصاب جماهير الناس المتأثرة بهذه الأحداث جعلت حياة الفرد الروحية الداخلية تبدو منفصلة عن الحياة الدنيوية الخارجية، وهي الحالة التي أصابت في واقع الأمر كل مظهر من مظاهر الحياة. ومن ثمَّ وجدت هذه الجماهير نفسها عاجزة عن التأثير تأثيرًا فعالاً في رسم معالم مستقبلها، كما أنَّها وجدت نفسها عاجزة عن المحافظة على سلامة أبنائها وبناتها من الناحية الأخلاقية، وهكذا غرق هؤلاء الناس جميعًا في أزمةٍ خانقة، ولئن اختلفت هذه الأزمة عن تلك التي كانت تستجمع قواها لاجتياح أوربا وأميركا الشمالية، فإنَّها في كثير من النواحي كانت أزمة أشدّ بطشًا ودمارًا. ومع أنَّ الدين احتفظ بدوره الرئيسي في وعي هؤلاء الناس، فقد بدا عاجزًا عن التأثير في مجريات الأحداث.
وفيما كان القرن العشرين يقترب من نهايته، لم يكن هناك من أمر محتمل الحدوث أبعد من إحياء الدين ليغدو موضوعًا يستأثر بالأهمية وليصبح الشُغل الشاغل لأهل الكرة الأرضية. لكنَّ إحياء الدين هو ما حدث بالضبط الآن متمثلاً في موجة عارمة من مشاعر القلق وعدم الرضا، وهي مشاعر لا تزال في معظمها مبهمة من حيث إدراكها الفراغ الروحي الباعث على هذه الحالة. والظاهر أن الصراعات المذهبية والطائفية القديمة باتت مستعصية إزاء حلول تطرحها مهارات دبلوماسية تتسم بالصبر وطول الأناة، فعادت هذه الصراعات وبرزت بشكلٍ كبير من الشراسة والضراوة لا يقل عنفًا عمَّا عرفه البشر سابقًا، فالمواضيع الرئيسية الواردة في الكتب المقدَّسة، وظواهر العجائب والمعجزات، والعقائد اللاهوتية، كل هذه الأمور التي اعتبرت حتى وقتٍ قريب من مخلَّفات عصر يتسم بالجهل وعدم المعرفة، غدت اليوم مادة للبحث والاستقصاء تعرضها وسائل الإعلام ذات النفوذ بالوقار والاحترام، وإن كان اختيار ما يُعرض مشوشًا غير متجانس. وفي كثير من البلدان صارت المؤهلات والكفاءات المكتسبة في ميدان الشئون الدينية عاملاً جديدًا ذا أهمية قصوى للمرشحين الطامعين في الفوز بالمناصب السياسية.
وأمّا العالم الذي افترض أنّه بسقوط حائط برلين انبثق فجر عصر السلام العالمي، فقد أُنذر علنًا بأنّه قابع في قبضة حرب دائرة الرَّحى بين الحضارات، معالمها الرئيسة تنافرات وصراعات دينية لا سبيل إلى حلِّها، ناهيك بما تبذله المكتبات ومنصّات الجرائد والمجلات ومواقع الشبكة العالمية للمعلومات والمكتبات العامة من جهدٍ في سبيل إشباع نهم جمهور من الواضح أنّه لا سبيل إلى إرضاء تطلعاته؛ فهو يطالب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن المواضيع الدينية والروحية. ولربما كان العامل الأكثر إلحاحًا في خلق هذا التحول والتغيير ذلك الاعتراف المتردد القائل إنه ليس هناك من بديل حقيقي للإيمان الديني كقوة يمكنها خلق الانضباط النفسي وإحياء الالتزام بالسلوك الأخلاقي.
أضف إلى أنّ الاهتمام الديني الذى بعثه الدين في صورته المعروفة قد بدأ يُركِّز الآن على إحياء البحث عن الروحانية على نطاق واسع. ولعلَّ في الإمكان تعريف هذا الاهتمام بوجهٍ عامٍّ على أنه رغبة مُلحَّة في اكتشاف الذات وتحديد الهويّة الشخصية بعيدًا عن مجرَّد كونها وجودًا ماديًا، وشجَّع هذا التطوُّر عديدًا من أنشطة كانت في طبيعتها إيجابية وسلبية. ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ تقصّي العدالة والترويج لقضية السلام العالمي من شأنهما أن يؤثِّرا أيضًا في خلق مفاهيم جديدة حول دور الفرد في المجتمع. ومع أنّ حركة الدفاع عن سلامة البيئة أو حركة المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ركّزتا اهتماماتهما على تعبئة الرأي العامِّ بغية دعم تغييرات مقترحة بخصوص كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع، فقد أوحتا إلى الناس بإعادة النظر في ما يشعرون به تجاه أنفسهم والتساؤل عن الغرضِ من حياتهم. ثمَّ هناك اتجاه جديد نجده في كلِّ الجامعات الدينية الكبرى متمثلاً في تهافت المؤمنين المنتمين إلى الفروع التقليدية لدينهم الأساسي، على الانضمام إلى فِرَق دينية فرعية تولي اهتمامًا أساسيًا في البحث عن الروحانية وفي التجارب الشخصية الخاصَّة بأعضائها. وفي المقابل برزت مظاهر جديدة مثل مشاهدات الكائنات غير الأرضية، وانتهاج أساليب في المعيشة تهدف إلى معرفة الذات، ثم الاعتكاف في الخلوات البريَّة، والمساهمة في حلقات الذِّكر والتهاليل الدينية الحاشدة المُهيِّجة للنفوس، والاندفاع بحماسة وتوق نحو اعتناق الأنماط المختلفة التي جاء بها عصر الروحانية الجديد، إضافة إلى انتشار تعاطي المخدرات وعقاقير الهلوسة كمنبهات للعقل الواعي لها فاعليَّتها وأثرها، وقد اجتذبت كل هذه المنازع أتباعًا فاقوا عددًا وتنوعًا أولئك الذين اجتذبهم في القرن الماضي مذهبُ الروحانيات والحركة الثيوصوفية عند نقطة تاريخية مشابهة لهذه المرحلة، أمَّا بالنسبة إلى الفرد البهائي فإنَّه، وإنْ كان انتشار الفرق الدينية الخاصَّة، وازدياد المراسم والطقوس المذهبية يثيران الاشمئزاز والنفور في أذهان عدد كبير من الناس، يعتقد أنّ هذه الشواهد تُذكِّر بالنظرة الثاقبة التي تضمّنتها الحكاية القديمة عن المجنون الذي كان يبحث في التراب عن محبوبته ليلى، ومع أنه كان يعلم تمامًا أنَّها مجرَّد روح، فقد أنشد قائلاً: "وعن ليلى أبحث في كلّ دربٍ علَّني أجد لها مكانًا". [۲]
وقد يبدو جلياً إذًا أنّ هذا الاهتمام الجديد لم يبلغ مداه بعد، أكان ذلك في مظاهره الدينية الواضحة أم في تلك المعالم الروحية الأخرى التي يصعب تحديدها. غير أنّ الأمر على عكس ذلك. فظاهرة الاهتمام بالدين تلك هي نتيجة تضافر قوى تاريخية تستجمع قدرتها على الاندفاع قُدمًا بخطى ثابتة. ولهذه القوى نتائج عامة تتمثل في زعزعة ذلك اليقين الذي ورثه العالم من القرن العشرين والقائل إنّ الوجود المادي يمثِّل الحقيقة المطلقة.
أمّا الأسباب الداعية إلى إعادة تقييم الأمور وإعادة النظر فيها من جديد فهي إفلاس المذهب المادي نفسه. فطوال مائة عام ونيِّف اعتُبرت فكرة التقدم والرقيِّ صنوًا للتنمية الاقتصادية وقدرتها على بعث التطور الاجتماعي وهيكلته. ولم تكن اختلافات الرأي آنذاك لتتعارض وهذه النظرة للعالم، كلّ ما هنالك أنّ الاختلاف في الرأي كان قائمًا بشأن المفاهيم المطروحة بالنسبة إلى أفضل الوسائل التي يمكن انتهاجها لتحقيق الأهداف النابعة من مثل تلك النظرة. ولعل أقصى حدٍّ بَلَغَهُ التعصب الأعمى لما عُرف”بالفلسفة المادية العلمية”هو سعيها إلى إعادة تفسير كل جانب من جوانب التاريخ، وكل مظهر من مظاهر السلوك الإنساني وفق مصطلحاتها الخاصة الضيقة المحدودة. ومهما كانت المُثل الإنسانية التي ألهمت ما أقدم عليه دعاة الفلسفة المادية الأوائل، فإن النتيجة العامة كانت قيام نُظُم الحكم الاستئثاري المستبدة، وهي النُظُم التي كانت على استعداد لاتِّخاذ أيِّ وسيلة من وسائل الكبح لإرغام شعوبها البائسة على التقيُّد بنظام واحد للحياة. أمّا الغاية المثلى لتبرير ما ارتُكب من الإساءة والأذى فكان الوعد بإقامة مجتمع جديد لا يضمن تخليص الناس من الفقروالعوز فحسب، بل يضمن لهم أيضًا تحقيق ذواتهم الإنسانية. وفي نهاية الأمر وبعد مرور ثمانية عقود من الزمان تفاقم فيه الحمق والوحشية، انهارت الثقة بالحركة المادية مرشدًا لقيادة العالم مستقبلاً.
أما النُظُم الأخرى في التجربة الاجتماعية فقد استقت دوافعها الأخلاقية والفكرية من مفهومها الضيّق نفسه للحقيقة ذاتها، رغم أنَّها نبذت استخدام الوسائل غير الإنسانية. وهكذا استقرَّ الرأي على أنه إذا كان البشر أصلاً يعملون بموجب مصالحهم الشخصية في ما يتعلَّق بسلامة أوضاعهم الاقتصادية، فإنّه بات من الممكن بناء مجتمعات تقوم على العدل والرفاهية بتبنِّي هذا المشروع أو ذاك من المشاريع التي توصف بأنّها "تَحديِثية" إلا أن العقود الختامية للقرن العشرين ناءت تحت وطأة ما تراكم من الدلائل التي تشير إلا أنَّ العكس كان هو الصحيح: إذ انهارت الحياة العائلية وتفاقم الإجرام، واختلّت نظم التربية والتعليم، إضافةً إلى قائمة طويلة من الآفات الاجتماعية المستشرية، ما يعيد إلى الأذهان كلمات حضرة بهاء الله خطيرة الشأن حين ينذر بما ستؤول إليه الأحوال في المجتمع الإنساني:
"وستتأزم الأمور، وتشتد إلى درجة ليس من المُجدي شرحها الآن." [۳]
إنّ مصير ما درج العالم على تسميته "التنمية الاجتماعية والاقتصادية" لم يترك شكًا في الأذهان بأنه لا مجال لنجاح أية محاولة لإصلاح عيوب المذهب المادي ومثالبه، حتى لو كان الحافز على هذه المحاولة أسمى النيّات المثالية الخيِّرة.
فقد وُلدت خطَط "التنمية" عقب الفوضى التي خلَّفتها الحرب العالمية الثانية، وصارت إلى حدٍّ كبير أضخم مهمة جماعية طَموح أخذها الجنس البشري على عاتقه، وكانت دوافعها الإنسانية توازي في عظمتها الاستثمارات المادية والتقنيَّة.
والآن بعد مُضيِّ خمسين سنة، ومع الاعتراف بفضل الفوائد العظيمة التي جادت بها التنمية، من الواجب أيضًا أنْ نحكم على مدى نجاح مشاريع التنمية هذه طبقًا للمعايير التي سنَّتها لنفسها، فإذا ما فعلنا ذلك وجدناها فاشلةٌ فشلاً يثير الخيبة في النفوس. فبدل أن يؤدِّي المجهود الجماعي الذي بدأ يُمثّل هذه الآمال العظيمة إلى تضييق الهوَّة الفاصلة بين أحوال ذلك القسم الضئيل من العائلة الإنسانية من الذين يتمتعون بِنعَمِ "الحداثة" وبين أحوال الأغلبية العظمى من البشر الغارقين في بؤرة الفقر واليأس، فقد أدّى ذلك المجهود إلى اتساع تلك الهوة اتساعًا هائلاً قاد إلى الحضيض.
إنّ ثقافة الاستهلاك حين لم تجد لها منافسًا أصبحت لنا تركة ورثناها اليوم عن رسالة المادية الخاصة بتحسين أحوال البشر، أمّا أهدافها وأغراضها الآنِّية العابرة فلم تسبّب للقائمين على تنفيذها أيِّ إرباك أو إحراج. أما في ما يخص تلك القلة المقتدرة من الناس فيمكنهم الحصول على تلك الفوائد فورًا، وما من عذر يبرّره العقل لوجود مثل هذه الحالة، وبانهيار نظم الأخلاق المتعارف عليها انتشرت العقيدة المادية الجديدة بجرأة، ولم يكن تقدمها سوى انتصار لدافع حيواني، غريزي وأعمى كالجوع مثلاً. وقد تحرَّر هذا الدافع الحيواني أخيرًا ممّا كان يضبطه ويقيده من الموانع الغيبية. وكان أبرز ضحايا هذه الثقافة واسطة التعبير عنها. ومن ثمَّ غدت النزعات، التي شجبها المجتمع على نحوٍ عام لكونها شذوذًا أخلاقيًا يستوجب التوبيخ والعقاب، من ضرورات تقدم المجتمع. وفي مثل هذه الظروف تصير الأنانية صفة لها قيمتها كموئل للتعامل التجاري. ويأخذ الزور والافتراء قالبًا جديدًا ويتحول مادة تغذي وسائل الإعلام. ويطالب بعض الناس دون أيِّ خجل بالاعتراف بأنواع مختلفة من مظاهر الشذوذ حقوقًا مدنية. واستُخدمت الكنايات تلطيفًا لبعض الألفاظ، فأصبحت كلمات الجشع والشهوة الجنسية والكسل والبلادة والكبرياء وحتى العنف، مقبولة على نطاق واسع، بل إنها اكتسبت أيضًا قيمة اجتماعية واقتصادية. ومن عجائب التقادير أنَّ المغانم المادية ووسائل الراحة التي صُلبت عليها الحقيقة قد فقدت طعمها على غِرار الكلمات التي أُفرغت من معانيها أيضًا.
من الواضح أن خطأ المذهب المادي لم يكن نتيجة جهوده الجديرة بالثناء لتحسين ظروف الحياة، بل كان نتيجة ما حدَّد رسالة ذلك المذهب من ضيق في العقل وثقةٍ بالنفس لا مبررِّ لها. ويجب ألاّ ننسى أن أهمية كلٍّ من الرفاهية المادية والتقدُّم العلمي والتقني المطلوب لتحقيق تلك الرفاهية هما من المواضيع التي يجري بحثها عبر الآثار الكتابية المقدسة للدين البهائي. وكما أنّه لم يكن من مناص في البداية من بذل جهود اعتباطية لفصل أسباب الرفاهية وسلامة الحال المادية عن تلك التي تساعد على التنمية الروحية والأخلاقية للبشر، انتهى الحال بالثقافة المادية إلى فقدان ولاء تلك المجموعات البشرية ذاتها التي ادَّعت أنها تخدم مصالحها. فلقد حذّر حضرة بهاء الله قائلاً: "انظروا كيف أصاب العالم بلاءٌ جديدٌ يتزايد آنًا بعد آن ... فالأمراض المزمنة التي أودت بالمريض إلى وهدة اليأس، ومُنع الطبيب الحقيقي الحاذق عن إشفاء المريض، وقُبِل عديم الخبرة غيره ليفعل ما يريد."[٤]
***
إضافة إلى خيبة الأمل بالنسبة إلى وعود المذهب المادي، ظهرت في القرن الحادي والعشرين قوة للتحوُّل والتغيير قوَّضت تلك المفاهيم الخاطئة المتعلقة بحقيقة الوجود الإنساني، وتمثّلت تلك القوة في السعي لخلق عالم موحَّد أو في ما يُعرف بـ "العولمة". وعلى أبسط المستويات تأخذ العولمة شكل وسائل اتصالات تقنية متقدمة تُفسح المجال للتفاعل بين مختلف سكان الأرض. ومع ما يُوفرُه تبادل الاتصالات بين الأشخاص والفئات الاجتماعية المختلفة، فإن سهولة الحصول على المعلومات لها من الأثر ما يساعد على تحويل ما تجمَّع من العلوم والمعارف عبر القرون إلى إرثٍ تستفيد منه الأسرة الإنسانية بلا تمييز من حيث الموطن أو العِرق أو الثقافة -. وهو إرث كان إلى وقتٍ قريب حِكرًا على صفوة مختارة من الناس. وليس في إمكان أيِّ مراقب حصيف أن يُنكر ما قد بعثته مثل هذه التغييرات من شحذ الهمم للتفكير من جديد في الحقيقة، بغضِّ النظر عن كلِّ ما تسببِّه العولمة من حِدَّة الجور والإجحاف. وقد أدى ذلك التأمل والتفكير الجادّ إلى تساؤلات طالت صلاحيات كلِّ سلطة قائمة، ولم يعد الأمر مقصورًا على تساؤلات عن صلاحيات سلطة الدين والأخلاق فحسب، بل تعدّى ذلك ليشمل الحكومات، والصروح الأكاديمية، والمؤسسات التجارية، ووسائل الإعلام، وبصورة متزايدة الآراء والنظريات العلمية.
وبصرف النظر عن العوامل التقنيَّة، فإنّ توحيد الكوكب له آثاره الأخرى على الفكر قد تكون أكثر مباشرةً ونفوذًا. فمن المستحيل المبالغة مثلاً في آثار التحول والتغيير التي خلّفتها في الوعي الإنساني بمطالب العولمة أسفارُ جماهير غفيرة من الناس على نطاق عالمي. إلا أن هذه الآثار على أهميتها لا تقاس بنتائج الهجرات الضخمة التي شهدها العالم إبَّان قرن ونصف منذ إعلان حضرة الباب دعوته. فقد اندفع الملايين من اللاجئيين الفارين من الظلم والاضطهاد كأمواج عارمة، واكتسح هؤلاء بصورةٍ خاصة القارات الأوربية والأفريقية والأسيوية.
وفي خِضِّم ما نجم عن هذا الاضطراب من مصائب وآلام نشاهد تزايدًا في اندماج أجناس البشر وثقافتهم كأنهم أبناء وطن عالمي واحد. وكان من نتيجة ذلك أن الناس من كل خلفية تعرَّضوا للتأثر بثقافات الآخرين وقواعد سلوكهم من الذين كانت معرفة الأجداد بهم معرفة ضئيلة أو تكاد تكون معدومة. وهكذا تولَّدت الحماسة لإجراء المزيد من البحث للكشف عن معانٍ لحقيقة هذا الوضع لا يمكن تجاهلها.
ولعلَّ من المستحيل أيضًا أن نتصوَّر كيف كان في الإمكان أن يختلف تاريخ السنوات المائة والخمسين المنصرمة عما عرفناه لو قام أحد القادة الرئيسيين في مجال الشئون العالمية من الذين خاطبهم حضرة بهاء الله، فخصَّص وقتًا للتأمل في ذلك المفهوم للحقيقة الذي عرَّفه حضرته. وأيَّد هذا التعريف ما كان يتمتع به صاحبه من صدقيّةٍ أخلاقية وروحية، وهي الصدقيَّة نفسها التي عبَّر هؤلاء القادة عن إجلالهم لها.
من الواضح لكلِّ فرد بهائي أنه برغم إخفاق هؤلاء القادة في الاستجابة لما دعاهم إليه حضرة بهاء الله، فإنَّ التحولات التي أُعِلنت في رسالة حضرته تتحقق دون أن يعوقها عائق. فمن خلال الاكتشافات المشتركة والمعاناة المشتركة وقف البشر المنتمون إلى ثقافاتٍ متعددة وجهًا لوجه. ورابطهم الإنساني المشترك كامن تحت سطحٍ من الاختلافات والفوارق في الهوية من صنع الخيال. فسواء عارضت بعض المجتمعات بعنادٍ وتعنُّت ذلك الشعور بأنَّ سكان الأرض هو بالفعل "أوراق شجرةٍ واحدة"[٥] أو رحبت به مجتمعات أخرى معتبرة ذلك انعتاقًا من قيودٍ مُحكمة لا معنى لها، فإن هذا الشعور يكاد يُصبح رويدًا رويدًا المعيار الذي بموجبه تقاس الجهود الجماعية للعالم الإنساني.
إنَّ انهيار الإيمان بالثوابت التي أقامها المذهب المادي وازدياد الخبرة الإنسانية في مجال خلق عالم موحَّد، هما عاملان يدعم كل منهما الآخر في بعث تلك الرغبة الجيَّاشة لدى الإنسان للتوصل إلى مفهوم حقيقي للوجود. وهكذا تمَّ تحدي القيم الأساسية والتنازل عن الروابط التي تُفرِّق وتحدُّ. وصارت المطالب التي لا تخطر في البال مقبولة. إن ما يحدث هو انقلاب العالم – كما صرّح حضرة بهاء الله – ووصفته الكتب المقدّسة للأديان السابقة مستخدمة الصورة المجازية "يوم القيامة".
وقد تفضل حضرته قائلا بهذا الخصوص "قد أتت الصيحة وخرج الناس من الأجداث وهم قيام ينظرون."[٦] فالسِّياق الجاري في طيّات ما نشهده من تفكك ومعاناة ما هو إلّا سياق روحاني في الأساس – "قد سَرَت نسمة الرحمن واهتزت الأرواح في قبور الأبدان."[۷]
كانت الأديان السماوية عبر التاريخ العامل الأساسي في التنمية الروحية للبشر. وبالنسبة إلى معظم أهل الأرض كانت الكتب المقدسة لكلٍ من هذه النظم الدينية، حسبما وصفها حضرة بهاء الله "مدينة الأحدية"[٨] وهي مصدر تلك المعرفة المحيطة بالوعي إحاطة كاملة، والتي لها من القوة والسلطان ما يُمكِّنها من أن تُنعم على المخلصين "ببصرٍ جديد، وسمعٍ بديع، وقلب وفؤاد جديد."[٩]
فهناك تراث أدبي واسع أسهمت في إبداعه كل الثقافات الدينية فسجلت في صفحاته ما مرّت به أجيال متعاقبة من سالكي سبل العرفان من تجارب، ناقلةً إلينا ما شاهده هؤلاء من تجلِّيات الرؤى الغيبية.
فمنذ آلاف السنين إلى وقتنا هذا كانت حياة أولئك الذين استجابوا للإشارات الإلهية مصدرًا للإلهام حقق إنجازات مذهلة في فنّي الموسيقى والمعمار وفنون أخرى، وإذ بخيرات الروح تلك تعود دومًا حية لتسعد الملايين من إخوانهم في الإيمان، وليس من قوة أخرى في الوجود استطاعت أن تبعث في النفوس مثل ما بعثته الأديان السماوية من مآثر البطولة ومناقب التضحية بالنفس والانضباط. أما على المستوى الاجتماعي فطالما تُرجمت المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الدين إلى قواعد عامة أخذ بها العالم في سّنِّ القوانين لتنظيم العلاقات الإنسانية والرفع من شأنها. وإذا ما نظرنا إلى الأديان الكبرى في نصابها الصحيح نجدها بمنزلة القوة الرئيسية التي تدفع بعجلة التقدم والرقي قُدمًا. وعكس هذا القول يكون بالتأكيد تجاهل لما يشهد به التاريخ.
فهل لنا أن نتساءل إذًا: لماذا لا يقوم هذا التراث موفور الثراء بدور رئيسي في يومنا هذا فيوقظ في النفوس من جديد توخي الحياة الروحية؟
إلاّ أنّهُ لابدَّ من الإشارة إلا أنَّ هناك محاولات هامشية صادقة لإعادة صوغ تلك التعاليم التي قامت عليها الأديان كل على حدة. وذلك أملا في جذب الناس إلى الدين من جديد. ولكن يبقى جلُّ هذه المحاولات للبحث عن معنى يحدِّدها متشعب الجوانب انفرادي المنحى، مشوشًا غير متماسك في طبيعته. فالكتب السماوية المقدسة لم يعتورها أيُّ تغيير، ولم تفقد المبادئ الأخلاقية التي احتوتها أيًا من صدقيّتها، فما من امرئٍ يتوجه إلى السماء مخلصًا في السؤال إلا ويكتشف – إن ثابر وألح ّ– جوابًا عن سؤاله، في "سفر المزامير" أو في صفحات "اليوبينشاد" (كتابات مقدسة عن الهندوس). وما من أحدٍ تجلَّى له بعض تباشير الحقيقة المتخطية حدود العالم المادي إلا تأثر تأثرًا بالغًا بكلمات يسوع المسيح: أو بوذا حين يتحدث كلٌّ منهما عن هذه الحقيقة حديثًا وديًا حميمًا. ففي نبوءات القرآن الكريم والرؤى الموحى بها عن يوم الدين تأكيد قاطع لمن يقرأها إن الهدف الإلهي عُمدَتُهُ إقامة العدل والإنصاف.
أضف إلى ذلك إن حياة الأبطال والقديسين في ما يميزها من خصائص لا تتضمّن اليوم من المعاني والدلائل أقل مما كانت توحي به أثناء حياة هؤلاء في ما مضى من قرون. ومن ثمّ فإنّ أشد جوانب الأزمة الحضارية الراهنة إيلامًا لمعظم المتدينين هو عجزها عن توجيه مساعي البحث عن الحقيقة الروحية بالثقة المطلوبة وقيادتها إلى دروب الدين المألوفة.
والمشكلة طبعًا ذات وجهين. فالنفس الناطقة لا تشغل مجرَّد حيز خاص بها فقط،بل هي تُسهم أيضًا إسهامًا فاعلاً في نشاطات النظام الاجتماعي. ورغم أن الحقائق التي وصلتنا عن طريق الأديان العظيمة لم ينتهِ أجلها بعد وهي لا تزال صالحة إلى اليوم، غير أن الخبرات اليومية الفردية في القرن الحادي والعشرين بعيدة كلَّ البُعد، بصورة لا يمكن تخيُّلها، عن تلك التي عرفها الفرد، أكان رجلاً أو امرأة، في أيٍّ من تلك العصور التي شهدت ظهور الهداية الإلهية. فانتهاج الطريقة الديموقراطية في اتخاذ القرار غيَّر طبيعة العلاقة القائمة بين الفرد والسلطة الخاضع لها أيًا كانت تغييرًا أساسيًا. وهكذا أخذت المرأة تسعى بكلِّ إصرار، وهي تزداد ثقةّ ونجاحًا، في المطالبة عن وجه حق بمساواتها بالرجل في كل الحقوق. ويجب ألا ننسى أن الثورات في العلوم والتقنية لا تحدث تغييرات في ما يسهم به المجتمع فحسب، بل تُحدث تغييرات في مفهوم المجتمع، وفي مفهوم الوجود نفسه أيضًا.
فانتشار التعليم انتشارًا عمّ العالم بأسره ، إضافة إلى فورة عارمة في مجالات جديدة من الخلق والإبداع، قد مهَّد السبيل لإيجاد مفاهيم ثاقبة للأمور تحثُّ على حرية التنقُّل والتحرك في المجتمع واندماج عناصره، وتخلق تبعًا لذلك فرصًا أمام المواطن للاستفادة منها كلَّ الاستفادة حسبما يُقرُّه القانون. فالأبحاث العلمية في مجال الحجيرات غير المُشخّصة، والطاقة النووية، وتشخيص الهوية الجنسية للفرد، وما يكشفه علم البيئة من اضطراب في نظام العالم البيئوي، وأخيرًا استهلاك الثروة – كلُّ هذه المسائل على أقل تقدير، تثير قضايا اجتماعية لم يسبق لها مثيل. وهذه التغييرات وغيرها من التحولات التي لا حصر لها والتي أثّرت في كل وجهٍ من وجوه الحياة الإنسانية، قد جلبت معها عالمًا جديدًا تتعدَّد فيه الخيارات أمام المجتمع وأفراده كلّ يوم. إنَّما الأمر الذي لم يطرأ عليه أيُّ تغيير هو أنَّهُ لا مفرَّ من فعل الاختيار خيرًا كان أم شرًا. وهنا بالذات تتمحور أهمية الطبيعة الروحية للأزمة الراهنة. لأن معظم الخيارات التي علينا اتخاذها ليست مجرَّد قرارات يمكن إجراؤها عمليًا بل هي قرارت ذات صِبغة أخلاقية أيضًا. وبناءً عليه كان فقدان الإيمان بالأديان التقليدية إلى حدٍّ كبير نتيجة حتمية للفشل الذي أصاب البحث فيها عن سُبُلٍ جديدة تهدي الناس حتى يتمكنوا من العيش بتوافق مع متطلبات العصر الحديث بكل ثقة اطمئنان.
أما ثاني الموانع أمام عودة النظم الدينية المتوارثة لإرواء غليل الإنسانية الروحي، فهو نتيجة مظاهر العولمة والمساعي القائمة لخلق عالم موّحد، سبق أن ذكرناها.
ففي كل جزء من أجزاء الكرة الأرضية يجد أولئك الذين نشأوا في بيئتهم الدينية الخاصَّة أنّه قد فُرض عليهم التعايش جنبًا إلى جنب مع غيرهم من الذين يدينون بعقائد وشعائر تبدو لأول وهلة منافية لما يدينون به على شأنٍ لا مجال إلى بحثه.
ومن الممكن أن تثير مثل هذه الاختلافات، وهذا غالبًا ما يحدث، مواقف دفاعية مضادة، مضافة إلى مظاهر نِقمة متأججة وصراع مفتوح. بَيْدَ أنه في كثير من الحالات تفضي هذه الأوضاع إلى إعادة النظر من جديد بالعقائد الموروثة، وتشجيع الجهود المبذولة على اكتشاف المبادئ والمُثُل المشتركة. ومما لا شك فيه أن الدعم الذي تتمتع به النشاطات المختلفة "لحركة تآلف الآديان" يُعزى بقدرٍ كبير إلى مثل هذه الجهود المبذولة. وبوجود مثل هذه الاتجاهات لابدَّ من طرح التساؤلات عن تلك العقائد الدينية التي تُحرِّم المعاشرة والتفاهم بين أتباع دين وآخر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: فإذا كان من الناس من يخالفك العقيدة أصلاً ولكنه على خُلق وفضيلة مشهودين، فلما الظن أن عقيدتك أنت هي الأفضل والأسمى؟ وبدل هذا السؤال قد يُطرح سؤال آخر: إذا كانت الأديان السماوية الكبرى تمتلك قيمًا وفضائل أساسية معينة تشترك في الدعوة إليها، ألا تُشكّل الولاءات المذهبية والطائفية إذًا خطرًا قد يفاقم دعم الحواجز غير المرغوب فيها بين الفرد وجيرانه؟
وأمَّا اليوم فقليل هم الذين لديهم معرفة موضوعية نوعًا ما بهذه الأمور، ومن المحتمل أن يساورهم الوهم إذًا بأن أيًّا من النُظُم الدينية القديمة القائمة مستتبة الأركان يمكنه أن يقوم بدور المرجع النهائي لهداية البشر في القضايا المتعلقة بالحياة العصرية، حتّى لو كان ذلك في ظروف لا يحتمل حدوثها مثل اتحاد المذاهب المختلفة مع تلك الأديان تحقيقًا لهذا الغرض. فكلُّ دين من الأديان التي يعتبرها العالم أديانًا مستقلة قد سُبكَ في قالب من صنع تاريخه والمصادر الموثوق بها من كتبه المقدّسة. ولأنه ليس في مقدور أيِّ دين من هذه الأديان أن يعيد صوغ نظامه العقائدي مستمدًا شرعيَّته ممّا أنزله مؤسّس ذلك الدين من صدق الآيات، كذلك ليس في مقدوره أن يجيب بصورة وافية عمّا يُطرح من تساؤلات كثيرة تُثار حول عملية الارتقاء والتدرج في المجالين الاجتماعي والفكري. وبرغم أنّ هذا الوضع باعث على الأسى والألم لدى كثير من الناس، فإنّه لا يعدو أن يكون مَعْلمًا آخر من المعالم المتأصلة في سياق التطوُّر والارتقاء. وأية محاولات ضاغطة لإحداث أيِّ تغيير معاكس لهذا الوضع سوف تكون نتيجته الوحيدة أن يفقد الدين مزيدًا من سلطانه ونفوذه في النفوس، وأن تتفاقم الصراعات بين فِرَق الدين وشِيَعِه.
إنّ الحيرة التي يواجهها العالم الإنساني هى حيرة مصطنعة ومن صنع أيدينا، فالنظام العالمي – إن جاز لنا أن نسمِّيه بهذا الاسم – والذي يواصل البهائيون فيه اليوم جهودهم كي يشاطرهم إخوانهم من البشر رسالة حضرة بهاء الله، نظامٌ حوله من المفاهيم الخاطئة للطبيعة الإنسانية ومسألة الارتقاء والتطور الاجتماعي على السواء. ما تمكنه من تعطيل الجهود الصادقة المبذولة لإصلاح العالم الإنساني وتحسين أوضاعه.
وتنطبق هذه الحال إجمالاً على الفوضى المحيطة بكلِّ وجه من الوجوه المتعلقة بموضوع الدين، وكي يتسنى للبهائيين تلبية المطالب الروحية لأقرانهم في الإنسانية تلبية وافية، عليهم أن يفهموا القضايا المتعلقة بهذه المطالب فهمًا عميقًا. وهذا الموقف الذي يتحدّى البهائيين لمجابهته يتطلَّب مجهودًا إبداعيًا يمكن تقديره حقَّ التقدير إذا أخذوا بتلك النصيحة التي لعلَّها أكثر النصائح التي تُردّد بإلحاح وتتكرر في الكتابات المقدسة لدينهم فتذكِّرهم بأن "يتأمَّلوا" في الأمور و "يتمعَّنوا" في إبداء الرأي و "يتبصَّروا" في مختلف الشؤون.
من الشائع في الأحاديث العادية بين الناس أنّ المقصود بالدين هو المجموعة الكبيرة من الفِرَق والشِيَع والمذاهب الموجودة حاليًا. وليس من المستغرب أن يثير مثل هذا التعريف الاحتجاج فورًا فى أوساط أخرى تعتبر أنّ المقصود بالدين هو واحد أو آخر من النُظُم العقائدية الكبرى المستقلة التي عرفها التاريخ، والتي ساهمت في رسم معالم حضارات إنسانية بأكملها، وكانت مصدر إلهامها. بيد أنّ هذا الرأي بدوره يجد صعوبةً في الردّ على سؤال لابدَّ من طرحه وهو أين يجد المرء مكان هذه الأديان التاريخية في العالم المعاصر؟ ويكون السؤال بالدقة: أين الدين اليهودي أو الدين البوذي أو الدين المسيحي أو الدين الإسلامي أو غيرها من النُظُم الدينية، إذ من الواضح أنه لا يمكنُ التعرُّف إليها من خلال تلك الهيئات والتنظيمات التي تتعارض وتلك الأديان تعارضًا لا سبيل إلى إزالته ولكنها تدَّعي التحدث رسميًا بأسمائها؟ ولا تنتهي المشكلة عند هذا الحدّ. إذ إن الرأي الآخر ردًا على السؤال سيكون حتمًا بأنّ المقصود بالدين ببساطة هو النهج الذي يتبنّاه الإنسان في الحياة، إضافة إلى شعوره بعلاقة تربطه بتلك الحقيقة التي تتجاوز حدود الوجود المادي. وفي هذا الإطار من التفكير يصبح الدين صفة تميز شخصية الفرد ودافعًا لا يخضع لمؤثرات أيِّ تنظيم، أو يغدو تجربة من التجارب سهلة المنال وعامة الانتشار. ولكنَّ الأغلبية من أصحاب الأفكار الدينية سوف ينظرون إلى مثل هذا الموقف على أنّه موقف يخلو من تلك السلطة بالذات التي تفرض الانضباط على النفس، وينفي وجود أيِّ نفوذ لتوحيد الصفوف وهو الأمر الذي يعطي الدين معناه.
وقد يذهب بعض معارضي هذا الموقف إلى الزعم بأنّ المقصود بالدين عكس ذلك، إذ هو حسب قولهم يعني منهجًا للحياة يتبناه أُناس من أمثالهم هم، يتِّبعون أسلوبًا دينيًا صارمًا بما يحتويه من شعائر دينية وطقوس يومية وتعفُّفٍ وإنكار للذات، يميِّزهم عن سائر أفراد المجتمع. فإن هذه المفاهيم المختلفة مشتركة أيضًا، إذا نظرنا إلى المدى الذي تحاول فيه احتواء ظاهرة متعارف عليها، ظاهرة لا سبيل للإنسان إلى نيلها إطلاقًا، ولكنها تصبح تدريجًا حبيسة حدود مفاهيم من وضع الإنسان، أكانت هذه المفاهيم تنظيمية أم لاهوتية، أم تجريبية، أم شعائرية.
إنّ تعاليم حضرة بهاء الله تمرُّ عبر هذه الآراء المتناقضة مختصرةٌ الطريق فتأتي بصياغات جديدة لكثير من الحقائق التي كانت، جوهر الوحي الإلهي ظاهرًا أم باطنًا. ورغم أنّه لا سبيل لأيِّ إنسان أن يحيط إحاطة كاملة بما يقصده حضرة بهاء الله، فإنه يوضح لنا أنّ أيَّ محاولة لتحديد الحقيقة الإلهية أو الإشارة إليها في الكتب اللاهوتية والفقهية أو في العقائد المذهبية إنما هي من قبيل خداع النفس: "ومن الواضح لدى أولي العلم والأفئدة المنيرة، أنّ غيب الهوية وذات الأحدية كان مقدسًا عن البروز والظهور، والصعود والنزول والدخول والخروج، ومتعاليًا عن وصف كل واصف وإدراك كل مدرك."[۱۰]
فالواسطة التي أبدعها خالق كلِّ شيء ليتفاعل مع خلقه في أطوار التقدُّم والنمو هو ظهور أصحاب النُبوّة الذين بهم تظهر صفات الحقيقة الإلهية المُنزهة عن الإدراك: "ولمَّا كانت أبواب عرفان ذات الأزل مسدودة على وجه الممكنات لهذا باقتضاء رحمته الواسعة.... قد أظهر بين الخلق جواهر قدس نورانية من عوالم الروح الروحاني على هياكل العز الإنساني، كي تحكي عن ذات الأزليُّة وساذج القِدَميَّة."[۱۱]
إنْ تجرّأ أحدٌ فى الحكم على رُسُل الله ممجدًا أحدهم على الآخر، سيكون ذلك بمنزلة استسلام لذلك الوهم المضلِّل بأنّ صاحب الديمومة المحيط بكلِّ شيءٍ خاضع لنزعات البشر وأهوائهم الطارئة في ما يفضِّلونه. وبهذا الصدد يُعبِّر حضرة بهاء الله بصريح البيان قائلاً: "إنّ من المعلوم والمحقق... أنّ جميع الأنبياء هم هياكل أمر الله، الذين ظهروا في أقمصةٍ مختلفة، وإذا ما نظرت إليهم بنظرٍ لطيف لتراهم جميعًا ساكنين في رضوانٍ واحدٍ، وطائرين في هواءٍ واحدٍ، وجالسين على بساطٍ واحدٍ، وناطقين بكلامٍ واحدٍ، وآمرين بأمرٍ واحدٍ."[۱۲]
وبعد كل هذا سيكون من الغرور أيضًا أن يظنَّ أحدٌّ أنّ في الإمكان – أو أنّ هناك حاجة إلى – تحديد طبيعة هذه النفوس الفريدة في قالب نظريات مستقاة من تجارب العالم المادي. ومن ثمَّ يشرح حضرة بهاء الله ما تعنيه عبارة "معرفة الله" مبيِّنًا أنّ هذه المعرفة هي معرفة مظاهر مشيئته وصفاته، وهنا تتصل الروح اتصالًا وثيقًا بالخالق المُنزَّه عن الوصفِ والإدراك، ويعود حضرة بهاء الله ليصف مقام المظاهر الإلهية مؤكدًا: "وأشهدُ أنْ بجمالك ظهر جمال المعبود، وبوجهكَ لاح وجه المقصود."[۱۳]
فإذا تيسَّر لنا أن نفهم الدين حسب هذا الاعتبار تستيقظ في النفس الإنسانية إمكانات لا يمكن تصوُّرها. فبقدر ما يتمكَّن الفرد من معرفة كيف يستفيد من نِعم الظهور الإلهي التي أغدقها الله على العصر الذي يعيش فيه ذلك الفرد، تغتني طبيعته على نحوٍ تصاعدي بما يُسبغ عليها من صفات العالم الإلهي، وحسبما تفضَّل حضرة بهاء الله:
"حتى يتعلَّم الناس جميعًا في ظل شمس الحقيقة، ويفوزوا بذلك المقام الذي استودعه الله في حقيقة ذواتهم......"[۱٤] وبما أنّ هدف الإنسانية السعي الدائم "لإصلاح العالم." [۱٥]
وخلق مدنيّة دائمة النموِّ والتطوُّر، فالقوى الخارقة التي يمتلكها الدين ليس أقلَّها قدرته على تحرير نفوس مؤمنيه من قيود الزمان نفسه، وباستطاعته أن يبعث فيهم روح البذل، فيقدّموا التضحيات لتخدم أجيالاً متعاقبة من المؤمنين قرونًا متتالية في المستقبل. والحق يقال إنّ الروح خالدة، ولهذا السبب إذا استيقظت فإنّها سوف تدرك جوهر حقيقتها، فيمنحها ذلك قوة وقدرة ليس في هذا العالم فحسب، بل عبر تلك العوالم الغيبية الأخرى بصورة أكثر مباشرة، وذلك بهدف دفع عجلة التطور والتقدُّم والرُقيّ. ويؤكد لنا حضرة بهاء ذلك فيتفضَّل قائلاً:
"إنّ ما تشرق به تلك الأرواح هو سبب ترقّي العالم وعلوِّ شأن الأمم... فالأشياء كلُّها لها أسبابها ودوافعها، والسبب الأعظم في تحريك العالم هو هذه الأرواح المجرَّدة...."[۱٦]
ومن ثمَّ فإنّ الإيمان دافع قويُّ لا تخمد جذوته بالنسبة للإنسانية التي وصفها أحد مفكِّري العصر الحديث من ذوي الشأن بأنَّها "إِنسانية تعي في ذاتها معنى التطوُّر والرُقي."[۱۷] فإذا ما سُدَّ الطريق أمام الإنسان ليُعبِّر تعبيرًا طبيعيًا عن إيمانه فإنّ ذلك سيدفعه إلى ابتداع صوامع للعبادة تُلبي لديه دافع الإيمان واليقين إلى حدٍّ ما، وقد تكون هذه الصوامع إمّا وضيعة أو غير لائقة، والدليل القاطع المؤسف على ذلك تؤكده لنا أحداث القرن العشرين، فالإيمان دافع لا يمكن أن يُحرَم منه الإنسان.
ويمكننا القول باختصار إنّه خلال تتابع الظهورات الإلهية، فإنّ المصدر النابع منه نظام المعرفة الذي ندعوه الدين يقيم الدليل على صدقيِّة ذلك النظام وخلوّه من المتناقضات التي تفرضها الطُموحات الطائفية والمذهبية. فكلُّ مظهر إلهي إنّما يؤدّي وظيفته وهو يتمتع بسلطته واستقلاله ولا يخضع لأيِّ حكم أو اختبار. ودَوْر كلِّ مظهر من المظاهر الإلهية يُمثِّل مرحلة من مراحل الظهورات اللامتناهية لتلك الحقيقة الواحدة التي لا رديف لها. وبما أنّ الهدف من تتابع المظاهر الإلهية حثُّ البشر والإهابة بهم لإدراك ما يتمتَّعون به من قدرات ويتولَّون من مسئوليات بصفتهم أوصياء مُؤتَمنين على الكون، فإن تتابع المظاهر الإلهية لا يعني مجرد تكرار لما سبق، بل تحرُّك إلى الأمام نحو مزيد من التطوُّر والتقدُّم، ولن يتمَّ تقدير هذا التتابع تقديرًا كاملاً إلا إذا نُظر إليه من خلال هذا السِّياق.
ففي هذه المرحلة المبكرة من تاريخ دينهم لا يمكن للبهائيين الزعم بأيِّ شكلٍ من الأشكال أنّهم أدركوا الحقيقة الكامنة في الظهور الإلهي الذي يقوم عليه دينهم إلاّ إدراكاً جدّ ضئيل لا أكثر. فبالإشارة إلى تطوُّر الأمر الكريم وتقدُّمه مثلاً يذكر وليُّ أمر الله شوقي أفندي ما يلي: "إنّ كل ما يمكننا أن نُقدِم عليه هو محاولة بذل قصارى الجهد لنفوز بلمحة خاطفة لتباشير ذلك الفجر الموعود الذي سوف يبدِّد عند تمام الوقت الظلام الذي أحاط البشرية بأسرها."[۱٨]
وبغضِّ النظر عمّا تبعثه هذه الحقيقة من شعورٍ بالتواضع، فإنّها تُذكِّرنا دومًا بأنّ حضرة بهاء الله لم يأتِ إلى الوجود بدين جديد ليقوم إلى جانب تلك النُظُم الطائفية والمذهبية مختلفة الأنواع والقائمة في ذلك الوقت، بل جاء ليصوغ مفهوم الدين صوغًا جديدًا معتبرًا إيّاه الحافز الأساسي لتنمية الوعي الإنساني.
وبما أنّ الجنس البشري بكل تنوعاته جنس واحد، فإنّ الواسطة التي يُنمِّي الله بها ما يتميَّز به الجنس البشري من خصائص العقل والقلب، هي أيضًا واحدة. ومن تجود به هذه الواسطة من أبطال إنما يُمثِّلون أبطال كلِّ مرحلة من مراحل الكفاح الإنساني وقدِّيسيها ؛ وكلُّ إنجاز يتمُّ تحقيقه يُمثِّل إنجازات كلِّ تلك المراحل. ولقد كان هذا هو الأُنموذج الذي مثَّله حضرة عبد البهاء في حياته ونشاطاته وهو النموذج الذي يتمثل اليوم في الجامعة البهائية التي أصبحت وريثة تراث البشرية الروحي وهو تراث في متناول أيدي سائر سكان الأرض دون أيِّ تمييز.
إنّ الدليل تلو الدليل المتكرر دوريًا على أنّ الله موجود، معناه إذًا أنّ الله سبحانه وتعالى، ومنذ غابر الزمان، يعود إلى إظهار نفسه باستمرار. أو بمعنى أوسع، طبقًا لما يوضحه حضرة بهاء الله فإن الظهورات الإلهية ليست سوى مشاهد الملحمة العظيمة للتاريخ الديني للجنس البشري تنفيذًا لبنود "الميثاق". والميثاق هو الوعد الإلهي المتين الذي قطعه خالق الوجود كلِّه وأكَّد فيه للبشر أنّ الهداية الإلهية الضرورية لنموِّهم الروحي والأخلاقي لن تتوقف، ودعاهم أيضًا إلى استيعاب هذه القِيمِ والمُثُل والتعبير عنها بالعمل. وللمرء مطلق الحرية في أنْ ينكر الدور المتميز لهذا الرسول الإلهي أو ذاك، وإذا كان هذا هو قصده يمكنه أن يعتمد في ذلك على التفاسير المبنية على النظرية القائلة إنّ للتاريخ منطقًا خاصًا خاضعًا لقوانين طبيعية وله أطوارٌ كلُ منها قائم بذاته. ولكن مثل هذه التكهنات لاتساعد على توضيح ما تمَّ من نموِّ الفكر الإنساني وتطوره، وما حدث من تغييرات في العلاقات البشرية ذات ضرورة ماسَّة بالنسبة لمسيرة التطوُّر والارتقاء الاجتماعي. لقد شهدت فترات نادرة من الزمان لدرجة يمكن عدّها على أصابع اليد، ظهور المظاهر الإلهية، فقد كان كل واحد من هذه المظاهر واضحًا كل الوضوح في ما يختصُّ بالتعاليم التي جاء بها ومدى سلطتها ونفوذها، وقام كلُّ واحد منهم أيضًا بالتأثير في تقدُّم الحضارة ورُقيِّها بصورة لا مثيل لها ولا يمكن مقارنتها بأيِّ ظاهرة أخرى من ظواهرالتاريخ، ويشرح حضرة بهاء الله ذلك فيتفضل قائلاً: "لاحظوا أنّه حين ظهور المظهر الكُلِّي، وقبل أن يكشف ذات القِدم عن نفسه وينطق بالكلمة الآمرة، كان الله عليمًا بكل شيء ولا من يعلم، وكان الله خالق الوجود كلِّه دون ان يكون هناك من مخلوق."[۱٩]
إنّ الاعتراض الذي يُوجَّه عمومًا إلى هذا المفهوم للدين الذي أشرنا إليه مردَّه التعنّت في الادعاء أنّ الفوارق القائمة بين الأديان السماوية المُنزَّلة فوارق أساسية وجوهرية إلى درجة لا تدع مجالاً لاعتبار هذه الأديان مظاهر نظامٍ واحد للحقيقة، فاعتبار كهذا يسيءُ إلى الحقيقة إساءةً بالغةً. لكنَّ هذا الاعتراض ليس إلا ردَّ فعل له مبرِّرات يسهل فهمها إذا ما أخذنا في الحسبان علامات الحيرة والارتباك في فهم طبيعة الدين وإدراك جوهره. ومثل هذا الاعتراض هو ما يتيح الفرصة للبهائيين في المرتبة الأولى ويدعوهم إلى بسط المبادئ المعروضة هنا بشكلٍ أدقَّ وأكثر وضوحًا في إطار ما تفضَّل به حضرة بهاء الله في كتاباته المباركة حول مسيرة التطُّور والرقيِّ.
إنّ الفوارق المشار إليها أعلاه تنقسم إلى قسمين: إمّا فوارق في الشعائر الدينية أو في تلك المتعلّقة بالعقائد المذهبية، يعرضها أصحابها على أنّها كانت المقصود مما جاءت به النصوص المقدسة المَعنية. أمّا في ما يختصُّ بالأعراف الدينية التي تخضع لأحكامها حياةُ الفرد الشخصية، فلعلَّ من المفيد لنا انْ نبحث هذا الموضوع آخذين بعين الاعتبار الخلفية التي ترعرعت فيها فوارق مشابهة تميَّزت بها الحياة المادية.
فالتنوُّع والاختلاف في أساليب الوقاية الصحية، واختيار الملابس وطرق المعالجات الطبية والغذاء، ووسائل المواصلات، وطرق شنِّ الحروب، وأنماط البناء والنشاطات الاقتصادية – مهما بلغ شأن هذا الاختلاف من غير المرجَّح أن يتخذه بعض الناس بعد الآن بجدِّية لدعم أية نظرية تدَّعي أنّ البشر لا يؤلِّفون في الواقع وحدةً لا مثيل لها. فقد كانت حتّى بداية القرن العشرين هذه الحجج الواهية شائعة بين الناس، بَيْدَ أنّ الأبحاث العلمية في ميدانيّ التاريخ وعلم الإنسان فتحت الباب أمامنا لنشاهد بصورةٍ عامة شاملة مسار التطوُّر الثقافي المتواصل،وهو التطوُّر الذي جاء بما لا يُعَدُّ ولا يُحصى من مظاهر الخلق والإبداع الأخرى التي انتقلت بدورها من جيلٍ إلى جيل، وتحولت تدريجًا تحولاً جذريًا وانتشرت بعيدًا في أغلب الأحيان لتُثري شعوبًا تقطنُ بلادًا نائيةً. ولأنّ مجتمعات اليوم تُمثِّل عديدًا من هذه الأعراف الدينية فليست ثمّة مجال البتَّة لتحديد هوية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لتلك المجموعات البشرية المعنية، بل كان كل ما هنالك أنّه في الإمكان فقط تشخيص المرحلة التي بلغتها مجموعات مُعيِّنة أو أنّها على الأقل مرّت بها منذ فترةٍ وجيزة. ومع ذلك فإنّ أمثال هذه الأعراف الثقافية كلها لا تزال في حالة غير واضحة المعالم نتيجة الضغوط الناجمة عن اندماج عناصر الكوكب الذي نعيش عليه.
ويشير حضرة بهاء الله إلى أنّ مسارًا مماثلاً للتطوُّر والنموِّ قد وجَّه حياة البشر الدينية. ولعلَّ الفارق الذي يميِّز هذه القواعد والأعراف الدينية المختلفة يكمُن في حقيقة الأمر في كونها سُنَّت بوضوح، في كلِّ حالة من الحالات، كإحدى الخصائص الجوهرية لهذا أو ذاك من المظاهر الإلهية، أضف إلى ذلك أنّ هذه الفوارق جسَّدتها النصوص المقدّسة، وطوال قرون من الزمان صمدت هذه الأعراف والقواعد دون أن ينال منها شيء، وحوفظ عليها بكل تفاصيلها.
بُناءً عليه فإنّ هذه الفوارق والاختلافات ليست صدفة من صُدَف التاريخ ولا استمراراً لمنهجه في اكتشاف الصواب بعد تكرار التجربة والاستفادة من الخطأ. وبرغم أنّ بعض الخصائص المعيَّنة لكل مجموعة من قواعد السلوك والأخلاق تستنفذ بمرور الوقت صلاحيَّتها وتتخطَّاها اهتماماتٌ تختلف في طبيعتها عن تلك القواعد، وهى اهتمامات يأتي بها مسار التطوُّر والارتقاء الاجتماعي، فإنّ تلك المجموعة من قواعد السلوك والأخلاق تبقى دون أن تفقد نفوذها وسلطتها إبّان تلك المرحلة طويلة الأمد من التقدُّم والرُقيّ الإنساني حيث كان لها دور حيوي في تربية البشر وتهذيب سلوكهم وتصرفاتهم.
ويؤكِّد لنا حضرة بهاء الله القول: "إنَّ هذه الأصول والقوانين والنُظُم المُحكَمَة المتينة مصدرها واحد وشعاعها شعاع نورٍ واحد، وكل ما اختلف منها كان حسب مقتضيات الزمان ومتطلبات القرون والأعصار."[۲۰]
ومن ثم يغدو الزعم أنَّ الاختلافات القائمة بين الأديان في الشعائر وقواعد السلوك والتصرُّف وغيرها من النشاطات الدينية تنفي حقيقة أنّ الأديان السماوية واحدة في أساسها يغدو هذا الزعم باطلاً لانّه يتجاهل الغرض الذي من أجله أُنزِلَت هذه الأديان. ولعلَّ الأخطر من ذلك أن مثل هذا الزعم يتجاهل الفرق الأساسي القائم بين ما لايتغيَّر ولا يتبدَّل من سمات الدين وبين سماته المؤقّتة الآنية المتغيرة حسب الزمان والمكان.
فجوهر الدين رسالة أبدية ثابتة الأركان، ووصف حضرة بهاء الله هذه الديمومة حين أعلن قائلاً : "هذا دين الله من قبل ومن بعد"[۲۱] فوظيفة الدين هي أن يمهِّد السبيل أمام الروح الإنسانية لترتقي وترتبط بخالقها في علاقة تتزايد نضجًا. وأن يسبغ على تلك الروح استقلالاً ذاتيًا متعاظمًا في ما تتحلَّى به من المُثل والأخلاق لتتمكَّن من السيطرة على الدوافع الحيوانية الكامنة في الطبيعة الإنسانية، وفي هذا كله ليس ثمّة تناقض بين التعاليم الأساسية التي تنادي بها الأديان قاطبة وتلك الإضافية التي يأتي بها كل دين لاحق من أجل هداية البشر ودعم تقدم مسيرته في بناء الحضارة الإنسانية.
إن مفهوم تعاقب المظاهر الإلهية يفرض الاهتمام كلَّ الاهتمام بالاعتراف بالظهور الإلهي عند بزوغ نوره. وكان لفشل غالبية البشر مرةً بعد أخرى في هذا المضمار تائجُ تمثَّلت في أنّ جماهير غفيرة من الناس حُكِمَ عليها بأن تخضع قسرًا للتمسُّكِ الشديد بالطقوس وتكرار مجموعةٍ من الشعائر والوظائف الدينية عفى عليها الزمن واستنفذت أغراضها، وباتت الآن مجرَّد عائق في سبيل أيِّ تقدُّم معنوي. وممّا يؤسف له في الوقت الحاضر أنّ فشل الاعتراف بالظهور الإلهي عند بزوغ نوره قد أدى إلى الإقلال من أهمية الدين والاستخفاف به. وفي اللحظة التي كانت الإنسانية تتطور تطورًا جماعيًا إذ واجهت تحديات عصر الحداثة، كان مَعين الروحانية التي كانت الإنسانية تستقي منه وتعتمد عليه أصلاً في تنمية شجاعتها الأدبية وتنوُّرها الفكري، ينضب بسرعة ويتحول مادة للسخرية والتهكُّم. وقد حدث ذلك في بادئ الأمر على مستوى الأوساط صاحبة القرار في توجيه المجتمع، ثمَّ انتقل إلى أوساط متَّسعة الحلقات ضمَّت عامة الناس. وممّا لا يدعو إلى كثير من الاستغراب هو أنّ هذه الخيانة التي تمثِّل أبشع أنواع التنكّر للأمانة وأكثرها ضررًا والتي عانتها الإنسانية وزعزعت ثقتها، قد نجحت على مدار الزمن في تقويض الأسُس التي يقوم عليها الإيمان بالذات. ولهذا يحثُّ حضرة بهاء الله مرةً بعد أخرى أولئك الذين يقرأون كتاباته على أنْ يفكروا مليًا في الدروس التي لقنَّها تكرار فشل الاعتراف بالمظهر الإلهي عند بزوغ فجر رسالته.
"تدبَّروا الأن وتفكَّروا قليلاً لمَ اعترض العباد من بعد طلبهم وانتظارهم ؟!"[۲۲] "ماذا كان سبب اعتراض العباد واحترازهم.. "[۲۳] "وماذا كان سبب أمثال هذه الاختلافات"[۲٤] "تأمَّلوا حينئذٍ ماذا كان سبب هذه الأفعال؟...." [۲٥]
ولعلَّ أبلغ الضرر الذي حاق بمفهوم الدين هو ما جاءت به الافتراضات اللاهوتية والفقهية، فمن السمات الدائمة في تاريخ الفِرَق والمذاهب الدينية هيمنة رجال الدين وسيطرتهم الكاملة. لقد كان من نتيجة غياب نصوص مقدّسة تحدِّد مركز السلطة في النظام الديني تحديدًا لا مجال للخلاف فيه، أنّ صفوةً مختارةً من رجال الدين نجحت في أنْ تنتحل حقَّ التحكُّم في تفسير ما أراده الله لعباده بحيث لا يشاركهم فيه أحد.
ومهما اختلفت النيّات وتنوعت فإن الآثار المفجعة لذلك كانت في عرقلة تيار الوحي في الأذهان، وتثبيط الهمم في مجال النشاطات الفكرية المستقلة، وتركيز الاهتمام بصورة مطلقة على صغائر المسائل المتعلقة بالطقوس والشعائر، وإثارة مشاعر الحقد والتعصّب في أغلب الأحيان ضدَّ هؤلاء الذين ينتهجون طريقًا مذهبيًا يختلف عن نهج من نصَّبوا أنفسهم قادة روحانيين. وفي حين لم يكن في إمكان أي شيءٍ أنْ يحول دون استمرار الواسطة الإلهية في القيام بوظائفها لرفع مستوى الوعي الإنساني وتقدُّمه، ضاق مدى ما يمكن تحقيقه من الإنجازات في أيِّ عصرٍ كان، وانحسر انحسارًا مطردًا بسبب تلك العقبات كألأداء التي ابتدعها واصطنعها أولئك القادة الروحانيون.
وبمرور الوقت نجحت العلوم اللاهوتية والفقهية في أنْ تقيم لنفسها في قلب كلِّ دين من الأديان الكبرى سلطةً تضاهي في نفوذها سلطة التعاليم المُنزَلة التي قام عليها الدين إضافة إلى كونها معادية في روحها لتلك التعاليم.
ومن الأمثال المعروفة التي وردت على لسان السيِّد المسيح حكاية صاحب الأرض الذي زرع أرضه حنطة، وهذه الحكاية تنطبق على المشكلة التي نحن بصددها وما يترتب عليها من نتائج في الوقت الحاضر، فلقد جاء في الكتاب المقدس ما يلي:
"وقدَّم لهم مثلاً أخر قائلاً يشبّه ملكوت السموات إنسانًا زرع زرعًا جيدًا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوُّه وزرع زؤانًا في وسط الحنطة ومضى"[۲٦] ولمّا جاء خدم صاحب الأرض واقترحوا أن يقتلعوا الزؤان أجابهم قائلاً: "لا لئلاّ تقلعوا الحنطة مع الزؤان وأنتم تجمعونه. دعوهما ينميان كلاهما معًا إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصّادين اجمعوا أولاً الزؤان واحزموه حزمًا ليُحرق، وأمّا الحنطة فاجمعوها إلى مخزني."[۲۷]
أما القرآن الكريم فقد خصَّ عبر صفحاته هيمنة أولئك الذين ينافسون الله فى سلطانه بالإدانة الشديدة لما يُحدثونه من أذىّ روحي، كقوله تعالى: "قل إنّما حرَّم ربّي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحقِّ وأنْ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون."[۲٨]
إنّ أجيالاً من أهل الفقه واللاهوت قد وضعوا اليد على الدين وأقاموا من أنفسهم أوصياء عليه، فكان عملهم ذلك خيانة دانتها النصوص المقدسة وحذَّرت منها بمنتهى الشدة. ومن سخريات القدر بالنسبة إلى أصحاب الفكر الحديث أن يلجأ أهل الفقه واللاهوت أولئك إلى استخدام ذلك التحذير نفسه الوارد في تلك النصوص فاستغلوه سلاحًا في أيديهم للقضاء على أيِّ اعتراض يوجَّه إليهم بخصوص اغتصابهم السلطة الإلهية.
وفي واقع الأمر أنّ كل مرحلة جديدة من المراحل التي تتكشَّف فيها مظاهر الحقيقة الروحية قد تجمدت في قالب الزمن وفي حُلَل براقة من حرفية الصور والتفاسير جلُّها مستعارٌ من ثقافات عفا عليها الزمن واستنفذت معاييرها الأخلاقية.
ومهما كانت قيمة بعض المفاهيم في أزمان غابرة من تطور وعي الإنسان وتقدُّمه مثل المفاهيم المتعلقة بقيامة الجسد، أو بفردوسٍ ملئ بما طاب من ملذات الدنيا، أو اعتقاد بالرجعة والتناسخ، أو عجائب الإيمان بوحدة الوجود، أو غير ذلك من المفاهيم الأخرى، فإنَّ هذه المفاهيم كلها صارت اليوم بمنزلة حواجز تفصل الناس بعضهم عن بعض، وتثير الصراعات بينهم في عصرٍ أصبحت الأرض فيه وطنًا واحدًا بكلِّ معنى الكلمة، وصار لزامًا على البشر أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم سكان هذا الوطن. ويمكن للمرء في هذا الإطار أنْ يُقدِّر حقَّ قدرها الأسباب التي من أجلها وجَّه حضرة بهاء الله إنذاراته الشديدة اللهجة وتحذيراته بخصوص ما تقيمه العصبيات الدينية اللاهوتية والفقهية من الحواجز في سبيل أولئك الذين يبغون تفهُّم المشيئة الإلهية، وفي هذا يتفضَّل حضرة بهاء الله قائلاً: "قل يا معشر العلماء لا تزِنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم إنَّه لقسطاس الحق بين الخلق".[۲٩]
وفي لوح وجَّهه حضرته إلى البابا بيوس التاسع يُخطِر فيه الحَبر الأعظم بأنّ الله في هذا اليوم قد "خَزَنَ ما اختار في أواعي العدل" كلِّ ما اصطفاه من مبادئ الدين الدائمة التي لا تتغيَّر "وألقى في النار ما ينبغي لها."[۳۰]
***
وإذا كان للعقل ان يتحرَّر مما أُحيط بالمفهوم الديني من سياج كثيف أقامه أهل اللاهوت والفقه، فإن بإمكانه حينئذٍ أن يسبر غور ما ورد في الكتب المقدسة من الآيات المعروفة فينظر إليها من خلال نظرة حضرة بهاء الله إلى هذه الآيات إذ يؤكِّد قائلاً: "إنَّ اليوم ليس له مثيل ولن يكون، لانَّه بمثابة البصر لما مضى من القرون والأعصار، وبمثابة النور في الظلمات."[۳۱]
ولعلَّ أروع ما يلُاحظ حين نغتنم فرصة الاستفادة من هذا المنظور هو وحدة الهدف والمبدأ التي نشاهدها منسابةً في كلٍ من النصوص العبرية المقدسة ومن آيات الإنجيل والقرآن الكريم، خاصَّةٌ أنّ هناك أصداءٌ يمكن اكتشافها بسهولة في الكتب المقدسة للأديان الأخرى من أديان العالم. إلا أنّنا نجد كيف تعود من جديد تلك المسائل التي ينتظم البحث بشأنها والنابعة من ذلك القالب المعروف الذي نُضِّد فيه كلُّ ما صيغ من وصايا ومواعظ وحكايات وقصص ورموز وتفاسير.
وليس من بين الحقائق الأساسية للدين حقيقة أبرز من تلك التي تنادي تباعًا نداءً وتنوِّه تنويهًا قاطعًا أكيدًا بأنّ الله إله واحد، وبأنّه خالق الوجود كلِّه، أكان ذلك العالم المادي أم تلك العوالم الغيبية القصيَّة، فها هو الكتاب المقدس يُذكِّرنا بقول الخالق: "أنا الرَّبُّ وليس آخر، لا إله سواي."[۳۲] وعزَّزت هذا المفهوم فيما بعد تعاليم السيِّد المسيح والنبيّ محمّد عليهما السلام.
لقد وُجِدت الإنسانية لتعرف خالقها وتُنفِّذ مراده، فالبشر هم ركيزة العالم الوارثون له والأمناء والأوصياء عليه. وما التعبُّد لله إلاّ أسمى وسيلة يمكن بها للدافع الإنسانى الخفي تلبية حاجة الإنسانية لمعرفة خالقها. فالتعبُّد لله حالة تستدعي أن يُسلِّم الإنسان أموره تسليماً قلبياً كاملاً إلى ذى القوة والسُلطان الجدير بالولاء والتعظيم: "وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يُرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور".[۳۳] ولا يمكن الفصل قطعاً بين روح التقديس والإجلال هذه وبين التعبير عنها تعبيراً يخدم بالفعل الهدف الإلهي الذى شاءه الخالق للجنس البشري: "قل إنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليم"[۳٤] . ويلقي هذا المفهوم ضوءاً ينير السبيل لتتوضَّح المسؤوليات التى يتحمَّلها البشر، فيصرّح القرآن الكريم: "ليس البِرُّ أن تولُّوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ولكنَّ البِرَّ من آمن بالله... وآتى المال على حبِّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين..."[۳٥] ويؤكد السيِّد المسيح لأولئك الذين استجابوا لدعوته قائلاً: "أنتم ملح الأرض"[۳٦] ويضيف أيضاً "أنتم نور العالم"[۳۷] ويلخِّص النبي ميخا فى سؤال يسأله،موضوعاً يعاد تكراره مرةً بعد آخرى فى النصوص العبرية المقدسة ويعود فيتكرَّر لاحقاً فى الإنجيل والقرآن الكريم، السؤال هو: "وماذا يطلبه منك الرَّبُّ إلا أن تصنع الحقَّ وتحبَّ الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك؟"[۳٨] تتَّفق هذه النصوص المقدّسة فيما بينها على أنّ توصُّل الروح الإنسانية إلى فهم غاية الخالق لن يكون بفضل مجرَّد ما تبذله من جهد، ولكن بفضل تلك الواسطة الإلهية التى تُمهِّد السبيل لتحقيق ذلك. وقد شرح السيِّد المسيح هذه المسالة بوضوح لا يمكن أن ننساه، إذ قال: "أنا هو الطريق والحقّ والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلاّ بي".[۳٩]
فإذا جاز لنا أنْ لا نأخذ هذا التأكيد على أنّه مجرَّد تحدٍّ جازم لتلك المراحل الآخرى من مراحل ذلك السِّياق الواحد المستمر للهداية الإلهية، فلعلَّه من الجائز أيضاً أن نجد فيه تعبيراً يوضِّح الحقيقة الرئيسية فى كلِّ دين من الأديان السماوية، ألا وهى أنّ الوصول إلى حقيقة الغيب الباعثة على الوجود وعلى دوامه واستمرار حياته، لايمكن أن يتمَّ إلا بواسطة الإشراقات المنعشة للروح والمنبعثة من ذلك الملكوت الإلهي. ويجدر بالذكر هنا أنَّ من أحبِّ الآيات القرانية إلى النفس تلك الآية الكريمة التي ترد فيها العبارة المجازية التالية: "الله نور السموات والأرض...نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء".[٤۰] أمّا بالنسبة إلى أنبياء بنى إسرائيل فإنّ الواسطة الإلهية التى عادت إلى الظهور في ما بعد المسيحية في شخص "ابن الإنسان" وبعد ذلك في الإسلام متمثِّلة في "كتاب الله"، قد اتخذت شكل ميثاقٍ مُلزِمٍ أبرمه الخالق العزيز مع إبراهيم الذي كان نبياً وزعيماً لقومه: "وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدًا أبديًا. لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك". [٤۱]
إنّ تتابع المظاهر الإلهية نجده فى كل الأديان الرئيسية فى العالم سِمَةً من السمات المذكورة ضمناً أو علناً فى الغالب، ولعلَّ أول وأوضح إشارة إلى تتابع المظاهر الإلهية جاء ذكره فى كتاب البهاغاواد-غيتا الهندي: "إنى آتي وأذهب، ثمَّ أعود، عندما تتضاءل التقوى، يا بهاراتا! وعندما يقوى الشرُّ، أعود من عصر إلى آخر وأتخذ لنفسي شكلاً يظهر للعيان ثمَّ أسير بين الناس رجلاً كغيري من الرجال، فأغيث أهلَ الخير وأدحر أهل الشرِّ ثمَّ أقيم الفضيلة على عرشها مرةً آخرى".[٤۲]
تمثِّل هذه المشاهد المتتابعة المستمرة البنية الأساسية للكتاب المقدس الذي تتحدث سلسلة فصوله المتعاقبة ليس عن رسالتيّ إبراهيم وموسى _ الذى عرفه الرَّبُ وجهاً لوجه"[٤۳] فحسب، بل تتحدث أيضاً عن ذلك الرهط من الأنبياء من غير أولي العزم، الذين قاموا على دعم وتطوير ما أتى به كلٌ من إبراهيم وموسى بصفتهما صاحبى مسار الأحداث الذي خطَّطا له وشرعا بتنفيذه. وبالمِثل فإنّه من غير الممكن أن تنجح التأويلات الملأى بالعجائب والمثيرة للجدل والخلاف والمتعلقة بحقيقة السيِّد المسيح وطبيعة حياته فى فصل رسالته عمَّا حققه كلّ من إبراهيم وموسى من تحوّل وتغيير وأثرهما على المسيرة الحضارية. ولكنَّ السيِّد المسيح أعلن بنفسه أنه ليس الذي سوف يحكم بين الناس ليدين أولئك الذين رفضوا رسالته،وذكَّر مستمعيه بأنّ الذي سوف يحكم عليهم هو موسى "الذي عليه رجاؤكم، لأنّكم لو كنتم تصدِّقون موسى لكنتم تصدِّقونني لأنه هو كتب عنيّ... فإنْ كنتم لستم تصدِّقون كتب ذاك فكيف تصدِّقون كلامي؟" [٤٤] وبنزول القرآن الكريم يصبح موضوع تتابع الرسالات الإلهية فيه موضوعًا رئيسًا: "قولوا آمنَّا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب... وما أُتي موسى وعيسى وما أُتيَ النبيون من ربّهم... " [٤٥]
ولابُدَّ لأىِّ مطّلع على أمثال هذه المقتطفات يتحلَّى بالموضوعية وينظر إليها بعين العطف أنْ يجد فيها إقراراً بأنّ الأديان في جوهرها واُسُسها دين واحد. وهكذا فإنّ لفظة "الإسلام" (ومعناها الحرفي هو التسليم لله) لا تعني مجرَّد رسالة خاصَّة بعثتها العناية الإلهية وجاء بها النبيُّ محمّد عليه السلام فحسب، بل تعنى أيضاً كما توضحه كلمات القرآن الكريم بشكل حاسم، أنّه الدين أيضًا.
فإنْ كان من صحيح القول التحدُّث عن وحدة الأديان كلِّها، فإنّه من الضروري أيضًا أنْ نفهم السِّياق الذى يأخذه هذا الحديث. وعلى أعمق المستويات، كما يؤكِّد لنا حضرة بهاء الله، لا يُوجد هناك إلاّ دينٌ واحد. فالدين هو الدين، تماماً كما أنّ العلمَ (النظامي) هو العلمُ أيضًا. يميِّز الدين المبادئ التى تتكشَّف متتابعة عبر الظهور الإلهي ويعرّفها، أمّا العلم فهو الوسيلة التي يقوم العقل البشري عن طريقها باكتشافاته ومن ثمَّ يمكِّنه ذلك من أنْ يؤثِّر دوماً تأثيراً تاماً على العالم الطبيعى الظاهر. فاالأول يحدِّد الأهداف التي تخدم أغراض مسيرة التطوُّر والتقدُّم، والثانى يساعد على تحقيق تلك الأغراض. فالدين والعلم يشكِّلان شِقَّي نظام المعرفة الذي يدفع بالحضارة الإنسانية قُدُمًا. وقد كرَّم حضرة عبد البهاء العلم والدين حين وصف كلاً منهما بأنّه: "إشراقات شمس الحقيقة".[٤٦] ومن ثمّ فإنّ الاعتراف بالمقام الفريد الذى يمثِّله كلٌّ من موسى وبوذا وزرادشت وعيسى ومحمّد إضافة إلى "مظاهر الحق" (Avatars) الذين صاغت إلهاماتُهم النصوص الهندوسية المقدسة، يبقى اعترافاً ناقصاً إذا ما اعتُبرت رسالة كلٍّ من هؤلاء رسالة قائمة بذاتها جاءت بدين جديد منفصل ومتميِّز. بل لأجل أن نفي هؤلاء حقَّهم من الإعزاز والتقدير علينا أن نعترف بأنّهم المربُّون الحقيقيون فى التاريخ الإنسانى وأنّهم أيضًا الباعثون على بناء حضارات ازدهر فيها الوعى الإنسانى. وها هو الإنجيل يعلن أنّ الله "كان فى العالم وكوَّنَ العالم..."[٤۷] وحيث إنّ هؤلاء قد حظيت شخصياتهم بإجلالٍ فاق بصورة لا حدّ لها ما حظيت به آية شخصية تاريخية أخرى، وانعكس هذا الاجلال فى محاولة التعبير عن مشاعر عميقة لا يمكن وصفها مسَّت أفئدة ملايين لا تُعدُّ ولا تُحصى من الناس بعثتها ما أغدقته عليهم إسهامات هؤلاء الرسل والأنبياء من عميم البركات، وهكذا تعلَّمت الإنسانية تدريجاً معنى محبة الله من خلال محبة البشر لهم. وفى الواقع ليس هناك من سبيل آخر لتحقيق ذلك.
ولن يكون إكرام هؤلاء الرسل والأنبياء في ما يُبذَل من جهود متعثِّرة لتحديد سرَّ جوهرهم الأصيل بابتداع عقائد يخترعها خيال البشر، بل إنّ إكرامهم الحقَّ يكمن فى أن تتنازل النفس الإنسانية عن ارادتها مسَلِّمة كلَّ أمورها دون قيد أو شرط لتكون خاضعة لقوى التحوُّل والتغيير التى جاءت بواسطة أولئك الرسل.
***
إنّ الارتباك الظاهر بشأن دور الدين في خلق الوعي الأخلاقي يظهر جليًا أيضًا في المفهوم العام للدورالذي يقوم به الدين في تشكيل بُنية المجتمع وتحديد معالمه. ولعلَّ أكثر الأمثلة جلاءٌ هو الوضع الاجتماعي الذي تحدِّده معظم النصوص المقدسة بالنسبة إلى المرأة بمرتبة أدنى من الرجل. ولقد كانت الفوائد التي انتفع بها الرجال نتيجة لذلك بلا شك أهمَّ عاملٍ في دعم هذا المفهوم المتعلق بوضع المرأة الاجتماعي، وبُنيت المبررات الأخلاقية لهذا الوضع على ما فهمه الناس أنّها مقاصد تلك النصوص المقدسة نفسها. وباستثناء عدد قليل منها فإنّ هذه النصوص تخاطب الرجال أولاً، وتخصص للنساء دورًا تابعًا للرجال ومساندًا لهم في الحياة الدينية والاجتماعية في آن. ومما يؤسَف له حقًا أن فهم الأمور على هذا النحو جعل من السهل وبشكلٍ شنيع أن تُلام المرأة في المرتبة الأُولى، وتُتَّهم بالضعف تجاه كبح جماح الغريزة الجنسية، باعتبار هذا النوع من الانضباط إحدى السمات الجوهرية في النموِّ الأخلاقي وتقدُّمه. وإذا نظرنا إلى وضع المرأة هذا من زاوية ما تنادي به الأفكار الحديثة لوجدناه بلا تردد موقفًا مجحفًا في حقها لأنه يتسم بالتعصُّب. ففي غضون مراحل التطوُّر الاجتماعي التي شهدت مولد كلِّ الأديان الكبرى، سعت الهداية التي تضمَّنتها النصوص المقدسة في المرتبة الأولى إلى تهذيب العلاقات القائمة بين البشر على قدر ما تسمح به الظروف والتي كانت حصيلة ظروف تاريخية صعبة وشديدة القسوة. ولا نحتاج إلى كثير من التبصُّر لندرك أن التشبُّث بقواعد السلوك والمعاملات البدائية في يومنا هذا لابدَّ أن يُعطِّل الهدف الحقيقي للدين في ما يبذله من جهد دؤوب لبعث معاني القيم والأخلاق في النفوس.
وثمَّة اعتبارات مشابهة لما قام من علاقات بين مختلف المجتمعات الإنسانية. فالمرحلة العسيرة الشاقَّة طويلة الأمد، التي احتاجها بنو إسرائيل ليُهيِّئوا أنفسهم لتحمُل الرسالة التي أُنيطت بهم، لدليل على الطبيعة المعقدة والمتصلبة للتحديات المعنوية التي انطوت عليها تلك الرسالة. ولأجل أن يتمَّ إنعاش تلك الإمكانات الروحية وازدهارها، والتي نادى بها أنبياء بني إسرائيل، كان من الضروري مقاومة المغريات التي عرضتها الثقافات الوثنية المجاورة مهما كلَّف الأمر. فالنصوص المقدسة في وصفها ما أُنزل من العقوبات اللائقة بحقِّ الحكّام وأتباعهم من الذين خالفوا ما أُمروا به لدليلُ على أهمية ذلك بالنسبة إلى الغاية التي أرادها الله. وقامت قضية مشابهة بعض الشيء تمثَّلت في كفاح الجامعة الإسلامية حديثة التكوين، والتي أنشأها الرسول محمّد عليه الصلاة والسلام، إذ صمدت أمام محاولات القضاء عليها من قِبَل القبائل العربية الوثنية التي كانت تُذكي حميَّتها قساوة الجاهلية وعقيدة الأخذ بالثأر، ولن يجد من له إلمام بالتفاصيل التاريخية أيّة صعوبة في إدراك السبب الذي من أجله كانت أوامر القرآن الكريم صارمة بصدد هذا الموضوع.
وإذ عُومِل اليهود والمسيحيون بالاحترام لأنّهم كانوا من الموحِّدين. فإنه لم يُسمَح بأيِّ تهاون مع عَبَدة الأصنام أو مساومة. ولم يمضِ سوى زمن قصير نسبيًا حتّى نجح هذا الاسلوب القاسي الصارم في توحيد قبائل شبه الجزيرة العربية، وفي توجيه الجامعة الإسلامية حديثة التكوين نحو انتهاج مسيرتها التي استغرقت أكثرمن خمسة قرون من الزمان وحقّقت فيها إنجازات أخلاقية وفكرية وثقافية واقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل في سرعة انتشارها ومدى اتساعها. وحكم التاريخ حكمٌ لا لين فيه ولا رحمة. وفي نهاية الأمر، ومن منظورٍ للتاريخ لا محاباة فيه، علينا أنْ نزن دائمًا ما أصاب أولئك الذين أعمتهم رغبتهم في وأد الدين الجديد في مهده بتلك الفوائد التي جناها العالم بأسره حين انتصر ذلك الدين محققًا رؤية الكتاب المقدس المتعلقة بإمكانات الإنسان وقدرته على الإنجاز والتقدُّم والتي ترجمها إلى الوجود نبوغ الحضارة الإسلامية. ولعلَّ من أكثر هذه القضايا إثارة للجدل والخلاف في فهم تطوُّر المجتمع الإنساني وتقدُّمه نحو النضج الروحي هي مسألة الجريمة والعقاب. وبرغم وجود اختلافات في التفاصيل المتعلقة بأحكام العقوبات وتفاوت في حدود تلك العقوبات ودرجة شدَّتها، فإنَّ الأحكام الواردة في معظم النصوص المقدسة الخاصَّة بأعمال العنف ضدَّ المصلحة العامة أو ضدَّ حقوق أفراد آخرين هي أحكام تميل إلى الشدَّة. وإضافة إلى ذلك غالبًا ما كانت تلك الأحكام توسِّع دائرة تنفيذها فتسمح للمعتدى عليهم بأن ينتقموا لأنفسهم أو أن ينوب عنهم في ذلك أي من أعضاء عائلتهم. أمّا من منظور التاريخ فمن المعقول أنْ يسأل المرء عن الخيارات العملية الأخرى التي كانت متاحة آنذاك.
ففي غياب البرامج المعاصرة لمعالجة السلوك الإنساني غير المقبول والسعي إلى تغييره، وانعدام إمكان اللجوء إلى تطبيق إجراءات قهرية مثل السجن أو وكالات للشرطة للمحافظة على النظام العامِّ، كان همُّ الدين في مثل هذه الأحوال أن يترك انطباعًا باقيًا في الوعي العامِّ بأن السلوك الذي يؤثِّر في تثبيط الهمم وعرقلة تقدُّم المجتمع ورُقيِّه سلوكٌ مرفوض أخلاقيًا ونتائجه في الواقع باهظة الثمن. وقد جنت الحضارة الإنسانية من ذلك فوائد جمَّة لاحقًا. والإقرار بهذه الحقيقة هو أقلُّ ما تفرضه علينا واجبات الصدق والأمانة.
وهكذا كان عليه الحال في الرسالات الدينية التي بقيت أُصولُها التارخية ومصادرها الأولى محفوظة في آثارها الكتابية التي وصلتنا. أما التسوُّل، والرِقّ، والحكم الاستبدادي، والفتح العسكري، والعصبيات الإثنية، وغير ذلك من معالم السلوك غير المرغوب فيه بالنسبة إلى التعامل والتعاشر في المجتمع – كلُّ هذه الموبقات غُضَّ الطرف عنها، ولم يُكبَح جماحها بل استمرَّت علنًا دون أنْ يحدَّها حدٌ. وحدث ذلك حين كان الدين يشغله سعيه إلى تحقيق إجراءات إصلاحية في أنماط من السلوك اعتُبِرَت في مراحل خاصَّة من مراحل تقدُّم الحضارة، أنَّها كانت حينذاك أكثر أهميةً وإلحاحًا من غيرها. إلاّ أنّه إذا أخذنا على الدين فشله في أيِّ دورة من دوراته المتتابعة في صبِّ كل اهتمامه على معالجة كلِّ نوع من أنواع المظالم الاجتماعية القائمة، فسيكون ذلك تجاهلاً منّا لكلِّ ما تعلَّمناه عن طبيعة التطوُّر الإنساني. وأيُّ تفكير من هذا القبيل عفا عليه الزمن وأصبح منافيًا لمتطلبات الحاضر ولابدَّ أن يقيم حواجز نفسية شديدة الوطأة تمنعنا من مواجهة مطالب زمننا الحاضر وتقديرها حقَّ قدرها.
فالماضي هنا ليس القضية، إنّما القضية فيما تفرضه أحداث الماضي من تَبِعات بالنسبة إلى الزمن الحاضر. وتقع المشكلات عندما لا يستطيع أتباع دين من الأديان العالمية التمييز بين الخصائص الأزليَّة التي لا تتغير في الدين وتلك الخصائص الأخرى المؤقّتة والمتغيرة. ومن ثمَّ يحاول هؤلاء أن يفرضوا على المجتمع قواعد للسلوك قد استنفذت أغراضها منذ زمنٍ طويل. وهذا التمييز يُمثِّل مبدءًا جوهريًا في إدراك مفهوم الدور الاجتماعي للدينِ، فقد تفضّل حضرة بهاء الله فبيَّن ما يأتي:
"إنّ ما يحتاجه العالم اليوم من علاج يشفي آلامه وأوجاعه لن يكون نفس العلاج الذي قد يحتاجه عالم الغد. إذًا اهتموا اهتمامًا عظيمًا بمقتضيات زمنكم وركِّزوا مداولاتكم حول مطالبه وحاجاته المُلحَّة."[٤٨]
إنّ الحاجات الماسَّة والمطالب المُلحَّة لهذا العصر الحديث من تاريخ الخبرة الإنسانية التي دعا حضرة بهاء الله قادة العالم من أهل السياسة والدين في القرن التاسع عشر إلى تلبيتها، قد تمَّ الآن تبنّيها إلى حدٍ بعيد – أو تمَّ اعتبارها مُثلُاً عليا في أقل تقدير – من قِبَل من خَلَف هؤلاء القادة أو من قِبَل أصحاب الفكر التقدُّمي في كلِّ مكان.
ولم يَكَد القرن العشرون يصل إلى نهايته حتّى أصبحت المبادئ التي كانت مدة عقود قليلة تعتبر سابقًا خياليةً ولا أمل في تحقيقها عمليًا، عمدةَ البحث والنقاش اليوم في المداولات المتعلقة بشئون العولمة. وقد أيّدت هذه المبادئ والأبحاث والاكتشافات العلمية وما توصَّلت إليه من نتائج اللجانُ المفوَّضة صاحبة النفوذ، وهي اللجان التي تجد عونًا ماليًا سخيًا، وباتت هذه المبادئ تقود نشاطات الوكالات ذات النفوذ على المستويات العالمية والوطنية والمحلية. وخُصِّص محصول ضخم من المنشورات العلمية بلغات عديدة للبحث عن وسائل عملية لتنفيذ تلك المبادئ، وحظيت هذه البرامج التي اقترحتها تلك الأبحاث باهتمام وسائل الإعلام في القارات الخمس.
ولكن معظم هذه المبادئ – وياللأسف- يُستهان به على نحوٍ واسع، ليس من قِبَل المعروفين من أعداء السلام في المجتمع فقط، بل من قِبَل أوساط تعلن التزامها بهذه المبادئ أيضًا. ولسنا بحاجة إلى دليل قاطع يقنع بصلاحية هذه المبادئ ومطابقتها لمقتضى الحال، إذ المطلوب وجود اقتناع معنوي له من القوة ما يجعله قادرًا على تنفيذ تلك المبادئ، إنّها القوة المعنوية التي أُثبتت بالدليل القاطع أنَّ منبعها الوحيد الذي اعتمدت عليه عبر التاريخ كان الإيمان بالله. وفي وقتٍ متأخر من الزمن وعند باكورة ظهور الرسالة الإلهية التي جاء بها حضرة بهاء الله، كانت السُلطات الدينية لا تزال تتمتَّع بنفوذ اجتماعيٍ على قدر كبير من الأهمية. وعندما تحرك العالم المسيحي ليقطع صلته بمبدأ اعتنقه بلا تساؤل طوال ألف سنة، وليعالج أخيرًا موضوع تجارة الرقيق والشرور النابعة منها، توجَّه المصلِّحون البريطانيون الأوائل إلى الكتاب المقدّس يستلهمون مُثلُه العليا وتعاليمه السامية.
وفي خطابٍ أدلى به رئيس الولايات المتحدة لاحقًا وحدَّد فيه الدور الرئيسي الذي كان لتجارة الرقيق في إشعال نار الصراع في أميركا أنذر قائلاً (كلُّ نقطة دم أسالها السوط سيكون ثمنها نقطة دم أخرى يسفكها السيف.) وكما صحَّ القول قبل ثلاثة آلاف سنة كذلك يصح اليوم (كما جاء في التوراة) "أحكام الرَّبِّ حقٌّ عادلةُ كلُّها"[٤٩]
غير أنّ ذلك العهد كان يقترب سريًعا من نهايته. وجاءت الحرب العالمية الثانية لتتبعها انقلابات وثورات لم تتمكَّن خلالها شخصية ذات نفوذ كشخصية المهاتما غاندي من استلهام القوة الروحية من الدين الهندوسي لتعبئة الصفوف دعمًا لجهوده في القضاء على العنف والقتال الطائفي في شبه القارة الهندية. ولم يكن قادة الجامعة الإسلامية هناك أسعد حظًا في التأثير على أتباعهم في هذا الأمر.
وقد عبِّر القرآن الكريم عن هذه الحال بأن رسم لنا رؤية وضعها في الصورة المجازية التالية: "يوم نطوي السماءَ كطيِّ السجلِّ للكتب".[٥۰]
فتلك السُلطة التقليدية المطلقة للدين التي لم يكن يعارضها أحد قد فقدت ما كان لها من نفوذ لإرشاد البشر وتوجيههم في إقامة علاقاتهم الاجتماعية.
وفي هذا السِّياق لعلَّ في إمكان المرء أنْ يبدأ بتقدير كلمات حضرة بهاء الله حقَّ قدرها، حيث اختار أن يصف بالاستعارة والمجاز مشيئة الله في هذا العصر الجديد: "لا تحسبنَّ أنَّا أنزلنا لكم الأحكام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار".[٥۱]
إنّ المبادئ التي استوجب وجودها النضجُ الجماعي للجنس البشري قد منحتها رسالة حضرة بهاء الله تلك القوة الوحيدة القادرة على اختراق جذور البواعث النفسية وتغيير أساليب السلوك والتصرُّف. أمَّا بالنسبة إلى أولئك الذين اعترفوا بحضرته وقبلوا دعوته فليس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء حجةٌ اجتماعيةٌ مُسلَّمٌا بها جدلاً، بل هو تشريع إلهي خاصّ بالطبيعة الإنسانية وله نتائج واعتبارات تتعلق بكلِّ جانب من جوانب العلاقات البشرية.
ويصدق هذا أيضًا على المبدأ الذي نادى به حضرته حول وحدة الجنس البشري ألوانًا وأعراقًا. أمّا تعاليمه وإرشاداته الأخرى مثل مبدأ التعليم الإجباري، وحرية الفكر، وحماية حقوق الإنسان، واعتبار موارد الأرض الوافرة أمانة يجب المحافظة عليها ليستفيد منها البشر جميعًا، ومسئولية المجتمع عن ضمان صلاح حال المواطنين من أفراده وخيرهم، وتشجيع الأبحاث العلمية ورفع مستواها، وأخيرًا ذلك المبدأ العملي المتعلق بإيجاد لغة عالمية تضاف إلى اللغات القومية، إنما هي جميعها عوامل من شأنها أن تساعد على اندماج سكان الأرض في وحدة جامعة. وبالنسبة إلى كلِّ من يستجيب للرسالة الإلهية التي جاء بها حضرة بهاء الله تحمل كلُّ هذه المبادئ والأحكام وأمثالها عين السلطة النافذة التي كانت تتمتع بها الأحكام والأوامر الواردة في النصوص المقدسة السابقة ضد عبادة الأوثان والسرقة وشهادة الزور.
وبرغم أنَّ هناك إشارات لبعض هذه المبادئ والإرشادات يمكن ملاحظتها في الآثار المقدّسة السابقة، فإنّ تعيينها بالتحديد آنذاك كان سابقًا لأوانه ووجب إرجاؤه بالضرورة حتّى يتمكَّن سكانُ هذا الكوكب، متعددو الأنواع والأجناس من الانضمام إلى صفٍّ واحد، فيسيروا معًا على دربٍ يكتشفون بواسطته أن طبيعتهم هي طبيعة جنس بشري واحد ليس إلاّ. وبفضل القوة الروحانية النافذة الخلاّقة لرسالة حضرة بهاء الله يصبح في الإمكان تقدير المُثُل الإلهية حقَّ قدرها، ليس كمبادئ وأحكام منفردة قائمة بذاتها فحسب، بل كمجموعة موحَّدة تُمثِّل جوانب مختلفة لرؤية واحدة شاملة لمستقبل الإنسانية، وهي رؤية ثورية في أهدافها ومذهلة فيما تتيحه من فُرَص وإمكانات.
وهناك مبادئ لا تتجزأ عن هذه التعاليم خاصَّة بإدارة الشئون الجماعية لبني البشر. ففي فقرة يكثر اقتباسها واردة في اللوح الكريم الذي وجَّهه حضرة بهاء الله إلى الملكة فيكتوريا يثني فيها حضرته ثناءٌ عطرٌا على مبدأ الحكم الديموقرطي والدستوري، كما يوجِّه في تلك الفقرة تحذيره من عدم تنفيذ هذا المبدأ في إطار الواجبات والمسؤوليات تجاه خلق عالم موحَّد، وضرورة هذا التنفيذ إذا أُريد لهذا المبدأ أنْ يحقِّق الغاية التي من أجلها وُجد هذا العصر: "يا أصحاب المجلس في هناك وفي ديارٍ أخرى تدبَّروا وتكلَّموا في ما يصلح به العالم وحاله لو أنتم من المتوسِّمين. فانظروا العالم كهيكل إنسان، إنَّه خُلق صحيحًا كاملاً فاعترته الأمراض بالأسباب المختلفة المتغايرة وما طابت نفسُه في يومٍ بل اشتد مرضه بما وقع تحت تصرُّف أطباء غير حاذقين الذين ركبوا مطيَّة الهوى وكانوا من الهائمين. وإنْ طاب عضو من أعضائه في عصرٍ من الأعصار بطبيبٍ حاذقٍ بقيت أعضاءٌ أخرى فيما كان..."[٥۲]
وفي مقاطع أخرى من هذا اللوح يشرح حضرة بهاء الله بعض الإجراءات العملية التي تتضمنها تلك الاقتراحات، فيدعو حضرته حكومات العالم إلى إنشاء هيئة دولية للتشاور لتكون أساسًا لما وصفه ولي أمر الله بأنه (نظام فدرالي عالمي)[٥۳] وتُخوَّلُ هذه الهيئة حقَّ الدفاع عن استقلال الدول الأعضاء فيها والمحافظة على سلامة أراضيها وتُمنح صلاحية فض النزاعات الوطنية والإقليمية وتنسيق برامج للتنمية العالمية تخدم مصالح الجنس البشري قاطبة.
ولعلَّه من الأهمية بمكان أنّ حضرة بهاء الله يقترح عند تأسيس هذا التنظيم منحه حقَّ استعمال القوة لوقف أي اعتداء تشنُّه أي دولة على أخرى. ففي بيان وجَّهه إلى حكّام عصره يؤكِّد الدافع الأخلاقي الواضح لمثل هذا الإجراء فيقول: "إن قام أحد منكم على الآخر قوموا عليه إنْ هذا إلا عدلٌ مبين."[٥٤]
***
إنّ القوة التي بواسطتها سوف تتحقَّق هذه الأهداف تدريجيًا هي قوة الوحدة والاتحاد، ورغم أنّ هذه حقيقة واضحة للبهائيين كل الوضوح، إلا أنّ ما يعنيه هذا الاتحاد فيما يختصّ بالأزمة الراهنة للحضارة الإنسانية قد تفاداها معظم الحوار الدائر اليوم بشأن هذا الموضوع. ولن تعارض إلاّ فئة قليلة من الناس القول إنّ المرض المستشري في العالم والذي يمتصُّ دم الإنسانية ويفتُّ من عَضُدِها ما هو إلا الفُرقة وعدم الاتحاد.
فنشاهد مظاهر عدم الاتحاد في كلِّ مكان وقد أصابت الإرادة السياسية بالشلل، وأضعفت العزيمة الجماعية في السعي للتحوُّل والتغيير، ونفثت السموم في العلاقات بين المواطنين والعلاقات بين الأديان. أليس من الغريب إذًا بعد حدوث سلسلة من الاضطرابات في عوالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والأخلاق، تمَّت معالجتها وحُلَّت بصورةٍ أو بأخرى، أنْ نجد أنّ مبدأ الاتحاد لا يزالُ يُنظر إليه على أنَّه هدف يُرجَى تحقيقه في المستقبل البعيد، هذا إذا أمكن بلوغه. ولكن هذه الاضطرابات في حقيقتها ما هي إلاّ أعراض المرض ومضاعفاته وليست أصل المرض نفسه. والسؤال هنا: لماذا قُلِبت الحقيقة من أساسها وتمَّ تصديقها بصورة واسعة؟
ولعلَّ الجواب عن هذا السؤال هو أنَّ السبب في ذلك هو الاعتقاد السائد أنّ المؤسسات الاجتماعية الموجودة حاليًا عاجزة كلِّ العجز عن تحقيق أيِّ اتحاد حقيقي يجمع القلوب والعقول بين أناس تختلف خبراتهم اختلافًا عميق الجذور.
وفي كل الأحوال فإن هذا الاعتراف الضمني هو خطوة محمودة تُمثِّلُ تقدمًا في التفكير في المفهوم الخاص بمراحل التطوُّر الاجتماعي الذي كان سائدًا قبل عقود قليلة ماضية، كما أنّه سيكون ذا فوائد عملية محدودة في مواجهة التحدِّيات القائمة.
إنّ الوحدة والاتحاد حالة من حالات النفس الإنسانية يدعمها ويُنمِّي قدراتها التعليمُ والتربية إضافةً إلى ما يمكن تشريعه من قوانين. ولكنَّ ذلك لن يحدث ما لم يصبح الاتحاد ذا كيان بارز، وما لم يترسَّخ وجوده قوة نافذةً ومؤثّرةً في حياة المجتمع.
فطبقة المثقفين من أنصار العولمة الذين تصوغ توصياتهم واقتراحاتهم المفاهيم المادية الخاطئة بالنسبة إلى ماهيّة الحقيقة، يتشبثون بشدة بأمل أن تتمكَّن المحاولات الفذَّة لإعادة تنظيم المجتمع مدعومةً بالمساومات السياسية من أن تُرجئ إلى أجل غير مسمى حدوث تلك الكوارث التي تلوحُ في الأفق مهددة مستقبل الجنس البشري، وهي الكوارث التي لا ينكر خطرها إلاّ فئة قليلة من الناس. وفي هذا الصدد يُصرِّح حضرة بهاء الله قائلاً: "إن مايمكن مشاهدته هو أن الجنس البشري بأسره محاط بالمصائب والآلام. فأولئك الذين أسكرهم غوى أنفسهم قد وقفوا حائلاً بين البشر وبين الطبيب الحاذق. فشاهِدوا كيف أوقعوا الناس جميعاً بما فيهم أنفسهم في مكائدهم. فهم عاجزون عن اكتشاف أسباب المرض ولا يعرفون له علاجًا." [٥٥]
وحيث إنَّ الاتحاد هو العلاج الشافي لأمراض العالم، فإنَّ مصدره الواحد الأكيد هو إحياء الدين وأثره الخيِّر في المعاملات والشئون الإنسانية، ويعلن حضرة بهاء الله أنّ المبادئ والأحكام التي أنزلها الله في هذا اليوم هي "السبب الأعظم والوسيلة الكبرى لظهور نيِّر الاتحاد وإشراقه."[٥٦] ويضيف أيضًا "كل ما يُشادُ على هذا الأساس لا تزعزعه حوادث الدنيا ولا يُقوِّض أركانه مدى الزمان."[٥۷] في صميم الرسالة الإلهية التي جاء بها حضرة بهاء الله إذًا دعوة إلى خلق مجتمع عالمي موَّحد يعكس وحدة الجنس البشري.
ففي نهاية المطاف إنّ جلَّ ما يمكن الجامعة البهائية أن تسوقه من الأدلة لإثبات صدق دعوة حضرة بهاء الله هو أُنموذج الوحدة والاتحاد الذي أنتجته تعاليمه. فالدين البهائي وهو يدخل القرن الحادي والعشرين إنما يُمثِّل ظاهرةً فريدةً لم يشهد العالم لها مثيلاً. فبعد عقود من الجهد تفاوتت فيه طفرات النموِّ وفترات الدعم والاستحكام طويلة الأمد، إضافة إلى ما جابهته الجامعة البهائية في أغلب الأحيان من نكسات وعوائق، نجد هذه الجامعة اليوم وهي تضمُّ عدة ملايين من البشر يمثِّلون تقريبًا كلّ خلفية إثنية وثقافية واجتماعية ودينية على وجه الأرض، يقوم هؤلاء على إدارة شئونهم الجماعية عن طريق مؤسسات تُنتخَب انتخابًا ديموقراطيًا، دون أيِّ تدخُّل من قِبل رجال الدين.
فآلاف المراكز المحلية التي غرست هذه الجامعة جذورها فيها موجودة في كلِّ دولةٍ وإقليمٍ ومجموعة من الجزر ذات الأهمية، وهي تمتد من القطب الشمالي إلى "تيارا دل فويغو" ومن أفريقيا إلى المحيط الهادي. ولعله من غير المحتمل أن يعارض أحدٌ من الناس على علم بالشواهد المتوافرة، الرأيَ الذي يؤكِّد أنّ الجامعة البهائية تؤلف أكثر المجموعات البشرية تنوعًا وأوسعها انتشارًا من الناحية الجغرافية، إذا ما قورنت بأيّة مجموعات بشرية مماثلة على هذا الكوكب.
وهذا الإنجاز يستدعي تفهُّمًا وإدراكًا لحقيقته. وقد يسوق تساؤلات تقليدية معروفة تنسب إلى عوامل مثل توافر المصادر المالية، أو رعاية لمصالح سياسية تخدم قوى ذات نفوذ، أو الاستعانة بالمعتقدات الغيبية، أو تطبيق برامج للدعوة والتبشير شديدة اللهجة تثير الرهبة في النفوس من غضب الله وعذابه – والواقع إنّه لم يكن لأيٍّ من هذه العوامل دور في ما حققته الجامعة البهائية من إنجازات. فقد تمكَّن أتباع هذا الدين من تحديد هويَّتهم كأعضاء جنس بشري واحد، وهي الهوية التي تصوغ أهداف حياتهم، والتي من الواضح أنَّها ليست تعبيرًا عن أيِّ شعور لديهم بالتفوُّق المعنوي على الآخرين "يا أهل البهاء إنْ لم يكن هناك من ينافسكم فذلك الفضل فضل عنايته ورحمته عليكم."[٥٨]
ولابدَّ للمراقب المنصف أن يفكِّر مليًا في أنّ الدين البهائي ظاهرة قد تكون – على الأقل – نتيجة عوامل ومؤثِّرات تختلف كل الاختلاف في طبيعتها عمّا اعتاده الناس وألِفُوه، إنّها العوامل والمؤثّرات التي يمكن وصفها صواباً بأنّها روحية فقط، فهي قادرة على أنْ تشحذ هِمَم أشخاص عاديين من كل خلفية فيحققوا مآثر من البذل والتضحيات والفهم والإدراك تبعث على الدهشة والإعجاب.
وممّا يسترعي الانتباه أنّ الدين البهائي قد حافظ على وحدته التي حققها دون أن يصيبها ضعف أو يعتورها خلل، وذلك إبَّان المراحل الأولى من تاريخه حين كان عرضة للهجوم والأذى. ولن يجدي البحث نفعًا في العثور على مجموعة أخرى من الناس في التاريخ – سياسية، دينية، أم اجتماعية – تمكنت من الصمود بنجاح أمام آفات التشرذم والانشقاق المستديمة. فالجامعة البهائية بكل تنوُّعها ليست إلا وحدة واحدة من البشر، متحدة في إدراكها لما أرادته الرسالة الإلهية التي بعثتها، متحدة في ولائها للنظام الإداري الذي جاء به حضرة بهاء الله لإدارة شئونها المشتركة، وهي متحدة أيضًا في التزامها في تنفيذ مسئولياتها من نشر رسالته في سائر أنحاء المعمورة. ورغم ذلك فإبِّان العقود التي استغرقها نموُّ هذا الدين حاول عدد من الأشخاص، بعضهم من ذوي الاعتبار وعلوِّ المقام وكلُّهم مدفوع بحافز من الطمع والطموح، بَذْلَ أقصى جهدهم لخلق أتباع منفصلين يدينون بالولاء لهم متأثِّرين بما قدَّمه هؤلاء من تفاسير شخصية فرضوها على ماجاء به حضرة بهاء الله في آثاره الكتابية. وعلينا ألّا ننسى أنّ في بواكير تلك المراحل التي شهدت تطوُّر كل دين قامت محاولات مشابهة لما ذكرناه ونجحت في خلق الفُرقة والانشقاق في تلك الأديان حديثة التكوين وتقسيمها إلى شِيع وفرق متنافسة . أمّا بالنسبة للدين البهائي فقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل دون استثناء، ولم تتمكَّن إلاّ من إثارة جدل مؤقّت كانت حصيلته النهائية أنْ ازداد إيمان الجامعة البهائية عمقًا بتلك الأهداف التي رسمها مؤسّسها وأرسخت لديهم الالتزام بها. وهكذا أكَّد حضرة بهاء الله لأولئك الذين آمنوا برسالته قائلاً: "إن نور الاتحاد والاتفاق نورٌ يضئ الآفاق كلّها."[٥٩]
ولما كانت الطبيعة الإنسانية على ما هي عليه، فلا يسع المرء إلاّ أن يُقدِّر حق قدره ما خطَّه ولي أمر الله مستبقًا الأمور ومؤكِّدًا أنّ تلك المحاولات بمثابة عمليات تطهير وستستمر زمنًا طويلاً وستكون بالضرورة، رغم هذا التناقض الظاهر جزءًا لا يتجزّأ من معالم نضج الجامعة البهائية.
***
ومن نتائج الابتعاد عن الإيمان بالله إصابة القدرة الإنسانية بالشلل مما أقعدها عن التصدي بفاعليّة مجدية لمعضلة الشَّر، وفي أغلب الأحيان تكون المسألة هى الإقرار بوجود هذه الآفة. ورغم أنَّ البهائيين لا ينسبون إلى ظاهرة الشرِّ وجودًا ماديًا ملموسًا قائمًا بذاته كما كان الظنُّ في المراحل الأولى من تاريخ الأديان، فإنّ انتفاء الخير الذي يُمثِّله الشر تمامًا كالظلام أو الجهل أو المرض له آثار شديدة الوطأة تشلُّ وتعطِّل. ولا يمرُّ موسم من المواسم الخاصَّة بدُور النشر وبيع الكتب إلاّ ويجد القارئ المثقف فيه سلسلة من الكتب الجديدة تحتوي على تحاليل جديدة واسعة الخيال لصفات بعض الأشخاص الأكثر شرًا وأذىً، ممّن ارتكبوا إبَّان القرن العشرين ضد الملايين من إخوانهم البشر جرائم شنيعة منظمة من تعذيب وإهانة وإبادة. وإذا أردنا أن ندرك كُنه ذلك الهوس الذي يسيطر على الإنسان سيطرة كاملة ويشعل نارًا لا يخمد أُوارها من الحقد والكراهية ضد البشر، فإنَّ العلماء الباحثين يدعوننا إلى التفكير مليًا في الأهمية التي يجب أن تُعطى إلى ضروب مختلفة من المشكلات. أكانت منفردة أو حِزمًا متفرقة مثل: فساد السلطة الأبوية، والعزل الاجتماعي، وخيبة الأمل المهنية، والفقر، والظلم، والحرب ومعاناتها، واحتمالات الإصابة بالعجز الوراثي، وأخيرًا انتشار الأدب العدمي الرافض للوجود والقيم الأخلاقية والدينية كافة. وقد غاب بشكلٍ ملحوظ في خِضمّ هذه المناقشات المبنية على الحدس والتخمين ما كان في إمكان المعلِّقين من ذوي الخبرة، حتى وقت قريب في القرن الماضي، أن يعترفوا بوجود مرض روحي أيًا كانت السمات التي تميّزه.
فإذا كان الاتحاد هو المعيار الدقيق النهائي الذي يمكن به قياس ما حققته الإنسانية من تقدُّم ورقيِّ، فلن يصفح التاريخ ولن تصفح السماء بسهولة عن أولئك الذين بمحض اختيارهم يتطاولون على الاتحاد ويصولون. فالاتحاد يبعث على الثقة، وإذا وثق الناس بعضهم ببعض فإنهم يمتلئون اطمئنانًا ويخرجون من خلف متاريسهم وينفتحون على الآخرين. ودون ذلك فلا سبيل أمامهم لكي يلتزموا الإخلاص الكامل لتنفيذ أهداف مشتركة. وليس أشدّ هدمًا للمعنويات من أن يكتشف المرء فجأة أن شريكه الملتزم بالعهد قد نقض ما أتُفق علنأ على تنفيذه معًا، وإنّ الالتزامات التي أبرمت بحسن نيَّة ما كانت إلاّ مجرد استغلال للموقف بغية جني منفعةٍ خاصَّةٍ، ووسيلة لتحقيق مآرب خفيّة تختلف عمّا جرى الإتفاق عليه وتتعارض مع ما التزم به. وأمثال هذه الخيانة نجدها خيطًا مسترسلاً عبر عصور التاريخ، وكانت أولى تلك الخيانات التي تمَّ تسجيلها هي الحكاية القديمة لقابيل الذي كان يحسد أخاه الذي اختاره الله ليزيده إيمانًا. وإذا كان للمعاناة المروعة التي أصابت سكان الأرض من درسٍ تلقوه في القرن العشرين، فإنّ هذا الدرس يكمن في أنْ ندرك أنّ التشرذم الذي ورثته البشرية من ماضٍ سحيق وأفسد العلاقات بين الناس في كلِّ ميدان من ميادين الحياة، باستطاعته في هذا العصر أنْ يفتح الباب واسعًا أمام تصرفات شيطانية تفوق في وحشيتها وعنفها ما لا يمكن لعقلٍ تصوره. فلو كان للشرِّ من اسمٍ يُطلَق عليه، لكان معناه بكلِّ تأكيد العمل عمدًا بغية نقض المواثيق التي تمَّ إبرامها بصعوبة بالغة لإحلال السلام والمصالحة، والتي بواسطتها يمكن لأصحاب النيّات الخيِّرة أنْ يسعوا إلى التخلُّص من رِبقة الماضي ويشرعوا معًا في بناء مستقبل جديد.
ويعتمد الاتحاد في طبيعته على الإيثار ونكران الذات وعلى البذل والتضحية. وقد أكَّد حضرة عبد البهاء ضرورة ذلك (.... لأنَّ طينة الإنسان مُخمَّرة بحبِّ الذات)[٦۰] ووصف الذات أو "الأنا" بأنّها "النفس الأمّارة"[٦۱] التي ترفض بالفطرة أيَّة حدود تُفرَض على ما تعتقده حرِّيتها. ومن أجل أن يتنازل الفرد بمحض اختياره عن الحرية التي تمكِّنه من إرضاء ما شاء من رغباته، عليه أنْ يصل إلى اقتناع بأنَّه سوف يُعوَّض عن ذلك في عالمٍ آخر. وفي نهاية الأمر يجد الفرد تحقيق شتى رغباته، كما هي الحال دائمًا في الإذعان لله والاستسلام له.
ونجد النتائج المدمرة للفشل في الاستجابة لما يتطلَّبه مثل هذا الإذعان والاستسلام لله ظاهرةً بصورةٍ خاصَّة عبر قرون من الزمان شهدت الخيانة التي تعرَّض لها رسل الله وما جاءوا به من المُثل والتعاليم. وليس هذا الحديث هو المكان المناسب لعرض طبيعة هذا الميثاق الخاصّ وبنوده، وهو الميثاق الذي حفظ بواسطته حضرة بهاء الله اتحاد أولئك الذين اعترفوا به وقاموا على خدمة هدف رسالته.
يكفينا هنا أن نلفت الانتباه إلى اللهجة الحازمة التي ينتهجها بيانه حين يتحدث عن أولئك الذين نقضوا الميثاق عمدًا، وتظاهروا في الوقت نفسه بالولاء له، ويصفهم قائلاً: "إن الذين غفلوا أولئك من أهل النار عند ربِّك العزيز المختار."[٦۲]
والسَّبب في استخدام هذه اللهجة الصارمة في إدانته لناقضي ميثاق الله واضح. وقليل هم الذين يجدون صعوبة في إدراك المخاطر الناجمة عن جرائم مألوفة مثل القتل والاغتصاب والاحتيال، وهي جرائم تهدد سلامة المجتمع وصلاح حاله، أو في إدراك حاجة المجتمع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية نفسه.
ومن هذا المنطلق يُطرح السؤال: كيف ينظر البهائيون إلى انحرافٍ سوف يهدم تلك الوسائل الأساسية الكفيلة بخلق الوحدة والاتحاد إن لم يتمَّ ضبطه؟
ويصف حضرة عبد البهاء هذا الانحراف عن الصراط المستقيم بكلمات لا لين فيها ولا هوادة فيصف أثر ظاهرة الانحراف هذه "بأنها فأس" تصيب "أصل الشجرة المباركة"[٦۳]
والقضية هنا ليست مسألة فكر معارض أو نقصًا في سلامة الخُلُق. فكثير من الناس لا يستسيغون الرُضوخَ لأيِّ سلطة، وفي نهاية الأمر ينأون بأنفسهم بعيدًا عن الظروف التي تستدعي وجود تلك السلطة. أمّا الأشخاص الذين اجتذبهم الدين البهائي وانضموا إليه ثمَّ قرروا لأي سببٍ من الأسباب ترك صفوفه فإنهم أحرار فيما يفعلون.
أمّا نقض الميثاق فظاهرة مختلفة في طبيعتها اختلافًا جوهريًا. فالدافع الذي تثيره هذه الظاهرة في نفوس أولئك الذين يخضعون لنفوذها ليس مجرَّد اختيار طريق يعتقدون أنه يحقِّق ذواتهم أو يسهم في خدمة المجتمع، بل لأنّ مثل هؤلاء الأشخاص هم بالأحرى مدفوعون على ما يبدو بعزيمة لا يمكن السيطرة عليها ليفرضوا مشيئتهم الشخصية على أفراد جامعتهم بأيِّ وسيلة من الوسائل المتوافرة لديهم، غير آبهين لما يلحقونه من الأذى والضرر وغير مقيمين أيَّ احترام للعهد المقدّس الذي قطعوه على أنفسهم حين انضمُّوا كأعضاء إلى تلك الجامعة. وفي هذا المقام تصبح نفس الفرد أخيرًا صاحبة السلطة العليا، ليس بالنسبة إلى حياة ذلك الفرد فقط، بل أيضًا بالنسبة إلى حياة عدد من الأفراد الآخرين الذين يمكن اجتذابهم والتأثير عليهم. لقد برهنت الخبرة الإنسانية الطويلة الملأى بالفواجع بصورة لا تدع مجالاً للشكِّ على أنّ المواهب المتميزة مثل علو النسب، أو رجاحة العقل، أو تحصيل المعارف، أو مناقب التقوى، أو مؤهلات القيادة في المجتمع هذه المواهب كلُّها يمكن إما تسخيرها لخدمة العالم الإنساني أو لإرضاء مطامح و مطامع شخصية على حدٍّ سواء. ولمَّا كان هدف الرسالة الإلهية طوال ما مضى من العصور مُركَّزًا على أسبقيات روحية مختلفة في طبيعتها فإنَّه لم يكن في الإمكان أنْ يتسبَّب مثل هذا التمرد وهذا العصيان في إفساد جوهر رسالة أيٍّ من المظاهر الإلهية المتتابعة. أما اليوم فمع ضخامة الفُرَص وعظم الأخطار التي جاء بها التطبيق المحسوس لاتحاد العالم، يغدو الالتزام بمطالب الوحدة والاتحاد هو المحكَّ لكل مظاهر الانقياد لمشيئة الله، وحتّى لكلِّ مشاعر الإخلاص بالنسبة إلى سلامة الجنس البشري وصلاح أحواله.
إن كل ماحدث في تاريخ الدين البهائي قد أهَّله ليواجه التحديات الماثلة أمامه اليوم. وحتّى في هذه المرحلة المبكرة نسبيًا من نموِّ هذا الدين وتطوُّره، وبرغم قلّة موارده المالية نسبيًا، فإنّ هذا المسعى البهائي جدير بما يناله من الاحترام والإكرام، ولا يحتاج أيُّ شاهد عيان إلى الإيمان بأنّ هذا الدين إلهيُّ الأصل لكي يقدِّر حق التقدير ما يقوم به من إنجازات. فلو نظرنا إلى الدين البهائي على أنّه مجرَّد ظاهرة دنيوية فإنَّ الجامعة البهائية في طبيعتها وإنجازاتها تبرِّر في ذاتها الاحترام الذي يكنّهُ لها أيُّ إنسان يهتمُّ اهتمامًا جديّاً بالأزمة التي تمرُّ بها الحضارة الإنسانية، وهي أيضًا شاهد على أنّ شعوب العالم المتنوعة باستطاعتها أنْ تعرف كيف تتعايش وتعمل في جوٍّ يحقِّق ذواتها كجنس بشري واحد يسكن وطنًا عالميًا واحدًا.
وتؤكِّد لنا هذه الحقيقة، إذا كان هناك ضرورة لمثل هذا التأكيد، الحاجة الماسَّة للمشاريع المتعاقبة التي يضعها بيت العدل الأعظم لدعم هذا الدين وانتشاره، ولسائر البشر الحقُّ كل الحقِّ في أنْ تنشأ لديهم التوقعات بالنسبة لإسهام هذه الجماعة من الناس الملتزمين بكلِّ صدقٍ وأمانة ما تمليه عليهم رؤية الوحدة والاتحاد التي تجسدها الآثار المباركة لحضرة بهاء الله. إنّ ما يتوقَّعه هؤلاء هو أن يكون لهذه الجماعة دورٌ متعاظم في الإسهام إسهامًا حيويًا في برامج الإصلاح الاجتماعي، وهي البرامج التي تعتمد في نجاحها بالذات على القوة المنبعثة من روح الوحدة والاتحاد. ولكي تتمكَّن الجامعة البهائية من تحقيق هذه التوقُّعات يتطلَّب ذلك منها نموًّا متسارعًا دومًا لتضاعف على نحوٍ أعظم ما تستخدمه من الموارد البشرية والمادية في نشاطاتها، كما أنَّ عليها أنْ تسعى إلى مزيد من التنوُّع في مدى ما يتوافر لديها من المواهب والكفاءات التي تؤهِّلها لتصبح شريكًا حقيقيًا للمنظمات التي تشاطرها الرأي والهدف. بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية لهذه الجهود يجب أن يدرك البهائيون أنّ هناك الملايين من البشر المخلصين أمثالهم، وهؤلاء لا علم لهم برسالة حضرة بهاء الله لكنَّهم قد تأثَّروا بكثير من مبادئ تلك الرسالة التي بعثت الإلهام في نفوسهم، وأنَّ تلك الملايين توَّاقة إلى فرصة مؤاتية لإيجاد حياة أساسها الخدمة لتكتسب تلك الحياة معنىّ لا يعرف الزوال.
إنَّ ثقافة النمو المنتظم التي أخذت جذورها تمتد في الجامعة البهائية يبدو أنَّها أبلغ ردٍّ مؤثِّر يمكن للأحباء أنْ يعطوه إزاء ما يواجههم من تحدٍّ طُرح في هذه الصفحات. فالخبرة التي يكتسبها المرء بعد درس الكلمة الإلهية الخلاَّقة درسًا يتَّسم بالعمق والجدية والاستمرار، تحرِّره من قبضة الظنون والأوهام المادية – التي يصفها حضرة بهاء الله بأنَّها "إشارات المظاهر الشيطانية"[٦٤] تلك الظنون والأوهام التي تتفشّى في المجتمع وتشلُّ دوافع التحول والتغيير. فالتعُّمق في فهم الكلمة الإلهية يبعث في النفس قدرة على دعم الأصدقاء والمعارف الذين يتطلَّعون بشوقٍ إلى إيجاد الوحدة والاتحاد وترجمة ذلك ترجمة تتَّسم بالذكاء والنضج. إنّ طبيعة النشاطات الأساسية للمشروع الحالي – كدروس الأطفال وجلسات الدعاء والحلقات الدراسية – تسمح لأعداد متزايدة من الأشخاص، الذين لا يعتبرون أنفسهم بهائيين بعد، بالاشتراك بحُرّية في هذه النشاطات.
ولقد كان من نتيجة ذلك أنْ ظهر إلى الوجود ما يمكن وصفه وصفًا ملائمًا بأنّه (مصلحة جماعية) أو (وحدة المصالح) وبينما يستفيد آخرون من الاشتراك في هذه النشاطات وتصبح الأهداف التي يسعى الدين البهائي إلى تحقيقها أهدافهم هم أيضًا، تدلُّنا الخبرة على أنَّ هؤلاء أيضًا يميلون إلى الالتزام التزامًا كاملاً بخدمة حضرة بهاء الله وتنفيذ رسالته تنفيذًا نشطًا. وبغضِّ النظر عمّا يتضمّنه المشروع المذكور من أهداف إضافية فإنّ تنفيذه تنفيذأ كاملاً،بناءً على ذلك، يبعث القدرة في الجامعة البهائية لتضاعف بصورةٍ هائلة إسهاماتها في الحوار العامِّ حول القضية التي صارت اليوم أهمَّ القضايا التي تواجه الجنس البشري، ألا وهي قضية خلق الوحدة والاتحاد.
ولكن إذا قُدِّر للبهائيين أن ينفَّذوا ما عَهِدَ الله به إلى حضرة بهاء الله من وظائف، فمن الواضح أنّ هناك ضرورة قصوى للبهائيين أنْ يأخذوا بعين الاعتبار أنَّه ليس هناك ثمَّة تنافس للاستحواذ على كامل الاهتمام بين تلك الجهود المتوازية، أيّ بين الجهود التي تسعى إلى إصلاح المجتمع وتلك التي تستهدف تبليغ أمر الله. فهذه الجهود كلُّها هي معالم متقابلة لبرنامج عالمي متماسك الجوانب. فاختلاف المناهج لا يتحدَّد غالبًا حسب اختلاف المطالب والحاجات وحسب اختلاف مراحل البحث والاستقصاء التي تواجه كل فرد بهائي. وحيث إنّ حرية الاختيار هى موهبة أصيلة من مواهب الروح، فإنَّ كلَّ شخص تجذبه تعاليم حضرة بهاء الله لبحثها ودرسها عليه أن يكتشف مكانه الخاصّ به في تلك السلسة المستمرة من الرحلة الروحية التي لا نهاية لها طلبًا للوصول إلى الحقيقة. وعليه أيضًا أن يقرر بنفسه ولنفسه في قرارة ضميره ودون أنْ يكون تحت أيِّ ضغط، تلك المسئوليةَ الروحيةَ التي تفرضها عليه رحلة البحث عن الحقيقة هذه. ولكي يتمكَّن الفرد من أن يزاول هذه الحرية الشخصية بفطنة وذكاء، عليه إذًا أنْ ينظر إلى الأمور من منظور مسيرة التحوُّل والتغيير التي يجد نفسه في مدارها كسائر إخوانه من سكان الأرض. وعليه أيضًا أن يتفهَّم ما يترتب على ذلك بالنسبة لحياته الخاصَّة. أما واجب الجامعة البهائية فهو أنْ تبذل كلَّ ما في وسعها كي تساعد كلَّ مرحلة من مراحل التحرُّك العامِّ الشامل للإنسانية نحو عودتها إلى الوصال مع الله. والخطة الإلهية التي ورَّثها حضرة عبد البهاء لهذه الجامعة هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها تنفيذ ذلك.
ولكنْ مهما كان مبدأ وحدة الدين مبدأً لا مجال لدحضه، فإنَّ مهمة إشراك الآخرين في رسالة حضرة بهاء الله ليست مشروعًا من مشاريع "حركة تآلف الأديان". فبينما يسعى العقل إلى بلوغ اليقين الفكري، تحنُّ الروح وتصبو إلى "الإيقان". ومثل هذا الاقتناع الداخلي هو الغاية القصوى لكلِّ باحث عن الروحانية بغضِّ النظر عن السرعة التي تستغرقها تلك الرحلة أو تدرُّجها. فالبنسبة للروح الإنسانية ليست خبرة الدخول في الدين أمرًا طارئًا أو ظاهرةً عَرَضيةً بغية استطلاع الحقيقة الدينية، بل هي المحور الذي يجب أن ينال الاهتمام في نهاية الأمر. وليس ثمَّة لبسٌّ أو مواربة في ما تحمله كلمات حضرة بهاء الله من المعاني حول هذا الموضوع، كما أنّه ليس ثمَّة لبس في أذهان أولئك الذين يقومون على خدمة أمره – يتفضل حضرة بهاء الله قائلاً: "في الحقيقة إنّ اليوم يوم المشاهدة والإصغاء، فقد ارتفع النداء الإلهي وأشرقت أنوار الوجه من أفق الظهور المُشرِق، وعلى الجميع محو ما سمعوه من قبل، وعليهم أن ينظروا بالعدل والإنصاف إلى الآيات والبيّنات والظهورات."[٦٥]
إنّ إحدى السمات المميَّزة للحداثة هي يقظة الوعي التاريخي يقظة عالمية في شمولها. ومن نتائج هذه اليقظة – التي تساعد على تبليغ رسالة حضرة بهاء الله بصورةٍ واسعة - أنَّها أحدثت تغييرًا ثوريًا في نظرتنا إلى الأشياء تَمثَّل في تمكُّن الناس، إذا ما أُعطوا الفرصة، من الإدراك أنّ مجموعة الكتب المقدسة التي عرفتها الإنسانية تشير إلى الشأن الأخير المتعلِّق بخلاص الروح وحصرها ضمن إطار التاريخ. إنّ للدين وراء لغة الرمز والمجاز، كما تُبيِّنه لنا النصوص الإلهية المقدسة، تأثيرًا في النفوس لا بفعل السحر بل لأنَّ الدين سياقٌ متواصل من الإيفاء يزدهر في العالم المادي الذي خلقه الله لذلك الهدف. وفي هذا الشأن تتحدث الكتب الإلهية بصوتٍ واحد إنَّ هذف الدين هو أنْ تبلغ الإنسانية عصر "يوم الحصاد"[٦٦] حيث يكون هناك "رعية واحدة وراعٍ واحد"[٦۷] إنه ذلك العصر الموعود الذي فيه "أشرقت الأرض بنور ربِّها"[٦٨] وهو العصر الذي تكون فيه مشيئة الله "كما في السماء كذلك على الأرض"[٦٩] "إنه ذلك اليوم الموعود"[۷۰] عندما تنزل "المدينة المقدّسة"[۷۱] "من السماء من عند إلهي"[۷۲] وعندما نجد "أنّ جبل بيت الرَّبِّ يكون ثابتًا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كلُّ الأمم"[۷۳] إنّه اليوم الذي فيه يسأل الله "ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟"[۷٤] إنّه ذلك اليوم أيضًا حين ُتفَضُّ فيه تلك الآيات الـ "المختومة إلى وقت النهاية"[۷٥] ويكون الاتحاد فيه مع الله "باسم جديد يعيِّنه فم الرَّب"[۷٦] إنَّه العصر الذي لم تشهد الإنسانية له مثيلاً، ولم يتصوَّره عقل، ولم تجد اللغة في كلماتها له وصفًا حتى الآن، وكما جاء في القرآن الكريم "كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنّا كنا فاعلين."[۷۷]
فالهدف المُعلَن للرسالات الدينية المتعاقبة في التاريخ إذًا لم يكن بغية هداية الفرد الواحد من روّاد الحقيقة السالكين طريق الخلاص الشخصي فحسب، بل أيضًا بغية تهيئة الأسرة الإنسانية بأسرها لاستقبال ذلك الحدث الخطير،الذي أشارت إليه الأديان السابقة مجازًا بأنّه اليوم الآخر الذي فيه تتجدد حياة العالم وتتغير تغيّرًا كاملاً. وما كان ظهور حضرة بهاء الله ليمهِّد السبيل أمام هذا الحدث أو التنبؤ بوقوعه، بل هو الحدث بعينه. فبواسطته وقوة نفوذه شُرِع في تنفيذ تلك المهمة الخطيرة لتشييد الأسس التي سوف يقوم عليها ملكوت الله على الأرض، وأُنعِمَ على سكان الأرض بالمواهب والقدرات اللازمة لتحقيق هذه المهمة.
وما الملكوت هذا إلاَّ حضارة عالمية تصوغها مبادئ العدالة الاجتماعية وتثريها الإنجازات الروحية والفكرية التي حقَّقها البشر على نحوٍ لا يمكن للعصر الحاضر أن يتخيله، وقد صرَّح حضرة بهاء الله بهذا الخصوص قائلاً: "اليوم يوم الفضل الأعظم والفيض الأكبر، وعلى الجميع أن يجدوا الراحة والاطمئنان بتمام الاتحاد والاتفاق في ظلِّ سدرة العناية الإلهية.... فلسوف يطوى بساط هذا العالم ويُبسط بساط آخر."[۷٨]
وخدمة هذا الهدف العظيم تستدعي تفهمًا للاختلاف الجوهري الذي يميِّز رسالة حضرة بهاء الله عن تلك المشاريع السياسية والعقائدية التي يبتدعها البشر. فالفراغ الأخلاقي والروحي الذي أنتج فظائع القرن العشرين كشف النقاب عن فشل اقصى قدرات العقل الإنساني، إذ كانت مجرَّدة من التأييد الإلهي، في رسم معالم المجتمع المثالي وتشييد أركانه، وذلك رغم كلِّ الموارد المادية الهائلة التي تُخصَّص لذلك المجهود. ونحتت تلك المعاناة من الأهوال والفظائع درسًا لا يُمحى من وعي شعوب الأرض وأُمَمها. فمنظورُ الدين الصحيح بالنسبة إلى مستقبل العالم الإنساني إذًا لاصلة بينه وبين نُظُم الماضي، وعلاقته بنُظم الحاضر علاقة واهية نسبيّاً. فالدين هدفه تلك الحقيقة الكامنة في الرمز التكويني (Genetic code) للنفس الناطقة، إن صحَّ التعبير. فقد علَّم السيِّد المسيح قبل ألفيّ عام من الزمان أن ملكوت السماء "داخلكم"[۷٩] ثمَّ هناك ما أورده من التشبيهات المحسوسة التي تشير إلى القدرات التي يتمتع بها النوع الإنساني، والتي تعهَّدها الله بالرعاية والتهذيب منذ بدء الخليقة كهدف للمسيرة الإلهية الخلاّقة، وكأقصى مرحلة من مراحل تقدُّم هذه المسيرة، ومن هذه التشبيهات التي ذكرها السيِّد المسيح كرم العنب.
ففي حديثٍ له يقول: "اسمعوا مثلاً آخر، كان إنسان ربَّ بيت غرسَ كرمًا وأحاطه بسياج وحفر معصرة وبنى برجًا وسلَّمه إلى كرّامين وسافر."[٨۰] ثمَّ إشارته إلى "المزروع على الأرض الجيّدة"[٨۱] أو إلى "شجرة جيّدة تصنع أثمارًا جيّدة"[٨۲
فالعمل الحثيث الدؤوب في تنمية المواهب والإمكانات هو المهمة التي أُلقى بها حضرة بهاء الله على عاتق أولئك الذين يعترفون به ويعتنقون أمره. فلا عجب إذًا أنْ يتحدَّث حضرته ببيان يتَّسم بالعظمة والجلال حين يذكر هذا الامتياز الخاص عظيم الشأن الذي أنعم به على أحبّائه "أنتم نجوم سماء العرفان ونسائم الفجر عند انبثاق النهار، وأنتم ماء الحياة المنسابة والتي بها يحيا كلُّ البشر.... "[٨۳]
إنّ المسيرة الإلهية تحمل في مكنوناتها ما يضمن نجاحها ويؤكِّد تحقيق أهدافها. فليبصر كل ذي بصرٍ أنّ الخلق الجديد بات اليوم ظاهرًا في كلِّ مكان، تمامًا كما تُنبت النبتة الواحدة بمرور الزمن شجرةً ذات ثمر أو كما ينمو الطفل ليصل سِنّ البلوغ. وعبر مظاهر إلهية متعاقبة قاد الخالق المقتدرُ المحبُّ لعباده سكان الأرض، كشعب واحد وأمَّة واحدة، نحو فاتحة عصر جديد لبلوغهم الجماعي مرحلة النضج والرشاد. وها هو حضرة بهاء الله يدعو البشر ليتولّوا زمام شؤون ما ورثوه ليقرروا مصيرهم، ويُذكِّرهم بما يحتاجه عالمهم لضمان سلامته وصلاحه فيتفضل قائلاً:
"والذي جعله الله الدِّرياق الأعظم والسبب الأتم لصحَّته هو اتحاد من على الأرض على أمرٍ واحدٍ وشريعٍة واحدةٍ".[٨٤]