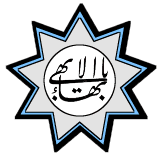مسافر إلى الله
محطّات في رحلة البحث عن الحقيقة
المحطَّة الثانية
حاجز الهويّة
بالرغم من تكويني العلمي وتركيزي الدراسي على الموادّ العلميّة التي خوّلتني أن ألج كلّيّة الطب وأصبح طبيبًا في النهاية، فقد كان لي حظٌّ وافرٌ بتلقّي تربية دينيّة رسَّخت في أعماقي مشاعر روحانيّة وطمأنينة داخليّة، وجعلتني متشبّعًا بثقافة عربيّة إسلاميّة أثَّرت في اختياراتي الفكريّة واهتماماتي الأدبيّة. وكنت منذ الصغر أميل في البحث والقراءة لكلّ ما له صلة بالأديان وقصص الرُّسل والأمم السابقة، ولكن من منظورٍ أحادي لمؤلِّفين عرب ومسلمين اجتهدوا ما استطاعوا في كتابة التاريخ وتفسير القرآن الكريم والسِّيرة النبويّة.
واليوم، بعد أن بدأت هذه المرحلة الجديدة من حياتي، وأخذت أراجع حقيقة ما نُقل إلينا من أثر وأحداث من صُنع البشر ومن شروحات وتفسيرات لمفاهيم وآيات، فاجأني أَنْ وجدت كثيرًا من الظنّ وكثيرًا من التساؤلات. وكنت عند كلّ سؤال أصطدم بحاجز "المُقدّس" وحاجز "الهويّة".
وفي أحد أيّام صيف سنة ٢٠٠٢م، وهي سنتي السادسة في كلّيّة الطب، جلسنا أنا وصديقي الوحيد في إحدى المقاهي الواقعة بحي أكدال المعروف بالعاصمة الرباط حيث تعوّدنا أن نتناول فنجان القهوة ونتبادل أطراف الحديث. كان اللقاء متميّزًا بكل المقاييس، وبدا وكأنّه لحظة بَوحٍ بسرٍّ دَفينٍ في ساعة صفاء وخشوع. فدار بيننا الحديث التالي:
- هناك سرّ لم أستطع إخبارك به...
- لا عليك !! فقط أخبرني ولا تخشى شيئًا.
- لديّ عقيدة مختلفة...
- كانت عندي بعض الشكوك... هل أنت مسيحي؟
- لا... إنه دين جديد.
- دين جديد ؟! منذ متى؟
- منذ أزيد من قرن ونصف.
...
استمرّ الحديث مدّة طويلة، توالت فيها الأسئلة دون انقطاع. إلا أنّ سؤالًا ظلّ يتردّد بداخلي ويبحث في صمت عن جواب: هل جاء وقت الامتحان، أنا الذي يبحث عن الحقيقة؟ هل هي ساعة الإيمان، أم لا زالت الشكوك عميقة؟ وكيف يؤمن من كان يعتقد نفسه في الأصل مؤمنا؟
إنّ بحثي في مسألة الإيمان والعقيدة جعلني أكتشف أشياء لم أكن أدركها من قبل، وبأنّ معاني هذه الكلمات هي أعمق ممّا نظن...
فالعقيدة إجمالًا تعني ما عَقدَ الإنسانُ عليه قلبَه جازمًا به من الأفكار والمبادئ، وصار بالنسبة له حقًّا لا يَقبل الشكَّ وإن كان غيره يراه باطلًا أو مخالفًا للصواب۲. من هذا نفهم أنّ العقيدة ليست بالشيء الثابت المستقِرّ ما دامت مبنيّة من جهة على الأفكار والمبادئ التي تتطوّر بتطوّر العقل والوعي، ومن جهة أخرى على القلب أي على الشعور بأحقّيّة الشيء دون أن تعلمه علم اليقين، وبالتالي فهي تتغيّر بتغيّر الإحساس والشعور. ولذلك حين تقول بأنّك تعتقد شيئًا ما فهذا يعني بالضرورة أنّ معرفتك غير مؤكّدة، وأنك تُقدّم فقط وجهة نظرك أو ما تؤمن به في مسألة يصعب فيها، أو يستحيل، الوصول إلى حقيقة مطلقة. وهذا سبب ارتباط الدين والعقيدة بمفهوم "الإيمان". وكلّها مفاهيم فلسفيّة تدلُّ على نسبيّة المعرفة.
فالإيمان لغة مشتقّ من الأمن ويعني الطمأنينة، وشرعًا يعني التصديق والإقرار۳. وهما شيئان متّصلان لأن التصديق بالشيء بعد صراع في الأفكار واضطراب في النفس والوجدان ينتج عنه سكينة واطمئنان.
وهذا يدفعنا للسؤال التالي: هل الإيمان لحظة بعينها نتبنى فيها فجأة هذه الأفكار وهذه المبادئ، أم أنّه عمليّة مستمرّة تتكشّف تدريجيًّا وتتطوّر إلى أن تصبح عقيدة راسخة، حتّى إنَّنا لا ندري متى أصبحت كذلك؟ وهل تُعدُّ الهويّة الدينيّة أو الانتماء الديني هويّة فطريّة تتأتّى بالولادة، أم أنّها هويّة مكتسبة بالبحث الجاد والمُضني، وبعد تحرّي الحقيقة بنِيَّة صادقة؟ وقبل ذلك كلّه، هل يعدُّ الانتماء الديني إيمانًا في حدّ ذاته؟ بدأ الموضوع يتشعّب والأسئلة تتكاثر...
لكن، كيف لنا ألّا نتساءل عن أصل الأديان ومصدرها؟ كيف لنا ألّا نتساءل عن وجود كلّ هذه الأديان مع بعضها؟ ألسنا جميعًا من أصل واحد وإلهنا إله واحد؟ فلِمَ لا يكون دين الله أيضًا واحدا؟ أم أنّه في كُنهه ومقصده كذلك، وإنّما اختلاف الأديان في مظهرها لا في جوهرها؟ أليس هذا مردّه إلى اختلاف المكان والزمان وتطوّر الإنسان؟ لماذا نجد، إذن، كلّ قوم بما لديهم فرحون، وفي كلّ مناسبة يردّدون: "نحن المختارون" و "نحن الفائزون"؟
وكيف لنا ألّا نتساءل: لِمَ الخالق عز وجل سيُجازينا ويُكافئُنا على دِينٍ تركه لنا آباؤنا وأجدادنا؟ ولِمَ يُحاسَبُ الآخرون ويُعاقَبون على دِينٍ تركه لهم آباؤهم وأجدادهم كذلك؟ ماذا فعل هؤلاء حتّى استحقّوا هذا التفضيل وهذا الامتياز؟ وماذا فعل أولئك حتّى نَالوا امتحانًا صعب الاجتياز؟ أم أنّنا في نفس الكفّة والميزان ما دمنا على نفس القدر من الإيمان؟
أظنّ أنّنا في حاجة إلى الغوص في معاني الكلمات والسياق التاريخي لظهورها وتداولها، ولكن قبل ذلك يمكننا طرح بعض التساؤلات البسيطة لعلّها تُقرّبنا من فهم الموضوع.
فمثلًا، من يولد من أبوين يهوديّين وفي مجتمع يهودي ما هي حظوظه ليعتنق المسيحيّة أو الإسلام؟ ومن يتربّى في مجتمع هندوسي أو بوذي كيف له أن يتعرّف على دعوة إبراهيم عليه السلام؟ وحتّى بالنسبة لدين بعينه، ينتمي المرء غالبًا لمذهب أبويه ومجتمعه ويكون مجرّد اختيار مذهب أو طريقة مختلفة خروجًا عن المألوف وتفريقًا للصّفوف، فكيف نسمّي الأمر إذن عقيدة؟ ثم من يتمرّد على هذا الوضع السائد ويتحرّى الحقيقة بنفسه ويختار دينه أو مذهبه، لماذا تتنكّر له جماعته الأصليّة وكأنّه لم يولد من صلبهم، ولماذا تجد الجماعة الدينيّة التي انضمّ إليها حديثًا ترحّب به أيّما ترحيب، وهو الغريب، وكأنّه تربّى بين ظهرانيهم؟
وإذا كنّا نعيش اليوم مرحلة العالميّة، حيث لا شيء يعلو على الهويّة الإنسانيّة، فلماذا لا زلنا نتمسّك بهويّاتنا الفرعيّة ونصرّ على أن نجعل منها "هويّات قاتلة"٤؟ لماذا ننحاز لكلّ من يشاركنا نفس العقيدة ونسارع للدفاع عنه ولو كان مذنبًا، ونتحامل على من خالفنا الرأي والهويّة ولو كان محسنا؟ هل هذا ما ينصّ عليه الدِّينُ حقًّا أم أنّ تعصُّبنا هو الذي يُعمينا؟ وإن كنّا نعتقد بأنّ الحقيقة الإلهيّة واحدة وبأنّ رسالة الأديان واحدة، ما همُّنا إن بقيت العقيدة نفس العقيدة أو جاءت بحلّة جديدة؟!
فبغضّ النظر عن انتمائنا الديني والطائفي، سنجد أنّنا في الغالب نؤمن بالخالق الغيب المنيع الذي لا يدركه إنسان، وبأنّ الهدف من وجودنا أسمى من الحرب والعدوان. وسندرك حينها أنّ قوى الهدم ليست لها هويّة ولا ترعى إلّا مصالحها الشخصيّة، وأنّ قوى البناء موجودة في كلّ الأرجاء ولا تحتاج إلى تعريف أو هويّة، فالشجرة الطيّبة تُعرف من ثمارها وتتزيّن بها كلّ بريّة. ولا يهمُّنا في الإنسان تَدَيُّنُه بقدر ما يهمُّنا ما يقدّمه للبشريّة.
فهل نحن مؤمنون حقًّا أم أنّ الدِّين بالنسبة لنا هو مجرّد انتماء وهويّة؟ بمعنى هل نختار ديننا انطلاقًا من تجربة روحيّة شخصيّة أم هي عمليّة وراثيّة تُحدّد الجزء الفطريّ من هويّتنا الفرديّة، مِثلها مِثل النسب ومسقط الرأس واللغة الأمّ والجنسيّة؟
هذا الأمر نلمسه بشكل أكبر في المجتمعات التي تتقاسم غالبيتها الهويّة الدينيّة نفسها، إذ يتبادر إلى الأذهان كيف أن الدِّين الذي يحثّ أتباعه على القِيَم والفضيلة والاتّصاف بمحاسن النعوت والأوصاف، وهذه خاصيّة مشتركة بين الأديان كافّة، لا يؤثّر في سلوكيات المجتمع وقِيَمه! وعلى العكس تمامًا، تُعاني هذه المجتمعات من تفشّي ظاهرتي الفساد والرشوة إلى حدّ كبير، ممّا يَحدّ من فرصها في تحقيق التقدّم والتنمية. ثُمّ كيف للطفل الذي يتلقّى هذه التربية الدينيّة أن يتشبّع بقيمها وهو يشاهد بين القول والفعل بونًا شاسعًا، بل تناقضًا ساطعًا، سواء في المدرسة أو البيت أو الشارع.
ربّما كانت الشعوب قديمًا لا تعتمد على التربية والتعليم في تحقيق رفاهيّتها، بقدر اعتمادها على بسط النفوذ والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، واستقدام العبيد للقيام بأعمال السُّخرة والأشغال الشاقة. والتاريخ يقف شاهدًا كيف بُنيت مدن بكاملها، وشُيّدت حضارات على جثث المستضعفين من غير أهلها. وبعد أن ذهب هذا الزمان الموحش بلا رجعة وظهرت معالم النظام العالمي الجديد، وعلى الرغم من السلبيّات والنقائص التي تعتري هذا النظام فهو لا زال يتطور ويتكشَّف باستمرار، أصبحت رفاهية الشعوب رهينة بمدى صحّة منظومتها المجتمعيّة ومدى اعتمادها على التنمية البشريّة المستدامة. لذلك، نجد أن مسألة الهويّة والقيم والتربية، وكذلك كلّ ما يتعلّق بالنظام وتدبير الشأن العامّ، كلّ ذلك أصبح يحتلُّ مكانة جوهريّة في تشكُّل المجتمعات وتقدُّمها. ولذلك أيضًا، نجد أنّ مجتمعات تفتقر إلى المساحات الشاسعة والموارد الطبيعيّة هي أكثر تقدّمًا من نظيراتها التي تنعم بكلّ الخيرات، وذلك بفضل تركيزها على رأسمالها البشري واستثمار طاقاتها في التعليم والتربية.
وفي هذه الحالة تمثّل التربية القائمة على القِيَم التزامًا مجتمعيًّا متكاملًا تنخرط فيه كافّة شرائح المجتمع وفئاته العمريّة، ممّا يخلق بيئة متوازنة تسمح بترسيخ القيم وتغلغلها في الحياة العامّة. وبالطبع لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك لولا وجود مساحة شاسعة من الحرّيّة. فحين يصبح الدِّين مجرّد هويّة مجتمعيّة يتمّ تدوينها أحيانًا في أوراقنا الثبوتيّة ولا يتسنّى لنا خوض تجربة الإيمان، فإنَّنا نفقد الدافع والمحفّز الذي يساعدنا على الالتزام بالقيم والارتقاء بماهيّتنا الروحانيّة. وحتّى إن لم نقتنع بفكرة الخلق والمصير، وسلّمنا بأنّ الأديان مجرّد أساطير، فإنَّنا سنعيش حياة متّزنة، وسنختار مرجعيّة تربويّة وقَيْمِيَّة تُناسب قناعاتنا وتؤثّر في وجودنا، بدل التظاهر باتّباع دِينٍ لا يُرضينا، وبالتالي لا يؤثّر فينا، ولكن لا نجرؤ على تغييره مثلما لا نجرؤ على تغيير أسامينا.
هكذا بدأت أكتشف تباعًا أن جُلّ المفاهيم المتوارثة حول الإيمان والعقيدة والدِّين بصفة عامّة هي ليست بالبساطة التي نظنُّها، أو ربّما هي ليست بنفس المعنى الذي تعوّدنا عليه!