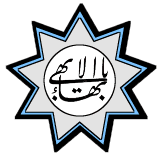مسافر إلى الله
محطّات في رحلة البحث عن الحقيقة
المحطّة الثالثة
في مفهوم الدّين
الدِّين رُؤية لا غِنى عنها في عالمنا اليوم، تحكم أفكارنا الشخصيّة والمجتمعيّة. لكنّ مفهومه فضفاض جدّاً ومعانيه تختلف بين ما هو متداول من مدلولاته اللغويّة والسوسيولوجيّة، وبين التعريفات القادمة من صلب الأديان نفسها.
فمثلًا ما نعرفه عن الِّدين إجمالًا هو كونه مصطلح يُطلق على مجموعة من الأفكار والعقائد التي توضّح، بحسب معتنقيها، الغاية من الحياة والكون وما يترتّب عن ذلك من أحكام وممارسات ومؤسّسات مرتبطة بذلك الاعتقاد٥. ويبقى هذا التعريف عامًّا وناقصًا إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ مفهوم الدِّين تطوّر عبر أشكال مختلفة في ثقافات شتّى. وبالتالي أصبح بديهيًّا أن يختلف تعريف الدِّين باختلاف النموذج الذي سيُتّخَذ كمعيار لهذا التعريف.
فلو طلبنا من أحد مثلًا إعطاء تعريف للدِّين، هل سيُعَرِّف "الدِّين" إجمالًا أم سيُعَرِّفه من خلال دينه ومعتقده؟ وهل نملك معرفة دينيّة غير تلك التي يُعطيها لنا ديننا؟ فتعريف البوذي أو الهندوسي للدِّين يختلف كثيرًا عن تعريف المسلم أو المسيحي أو اليهودي لهذا المفهوم. وهل الذي لا ينتمي إلى أيّ دين من الأديان الموجودة، أو لا يؤمن بتاتًا بفكرة الإله الخالق والعقيدة، سيتّبع نفس المنهجيّة ونفس النمطيّة في الوصف الذي سيعرّف به الدِّين أو الأديان على اختلافها؟ إذن، ما دام الأمر بهذا القدر من التعقيد، لماذا نتحدّث عن الدِّين وكأنّه مفهوم موحَّد وله نفس التعريف؟!
من ناحية أخرى لماذا يجب علينا أن نعتبر الدِّين، على اختلافه، ضرورة مجتمعيّة تنظّم شؤون الفرد والجماعة؟ ألا تعدُّ أغلب الدول المتقدّمة دُوَلًا علمانيّة تفصل بين الدِّين والنظام المجتمعي؟ إنّها مجتمعات بعيدة كلّ البُعد فكريًّا واجتماعيًّا عن تأثير الدِّين وهيمنته على الأفراد، فلم يَعُد لها من مظاهر التديُّن سوى بعض الأجراس الموغلة في القدم وبعض الاحتفالات السنويّة. ثُمّ ما الذي يُعطينا الانطباع بأنّ الدِّين والسياسة شيآن مختلفان حتّى نستطيع الفصل بينهما؟ أسئلة كثيرة تحوم حول مفهوم الدِّين في عالم معاصر تغيّرت فيه المفاهيم، وتبدّلت الأنظمة، وتعقّدت العلاقات الاجتماعيّة، وأصبحت العولمة واقعًا ملموسًا وإطارًا جامعًا لإنسانيّة مراهقة تحثّ الخطى نحو بلوغ رشدها ووحدتها...
لذلك، إذا حاولنا اليوم أن نعطي تعريفًا لمفهوم "الدِّين" بعيدًا عن الأوصاف والتصنيفات الانتمائيّة، سنجد أنّنا بصدد مجموعة من الأفكار المجرّدة، والقيَم، والتجارب القادمة من رحم الثقافة، والتي تُشكِّل في مجموعها أسلوب حياة بعينه٦. ولعلّ أهمّ ما يميّز هذه الأفكار هو الجانب الذي يحاول الإجابة عن تساؤلاتنا الوجوديّة المرتبطة بمسألتي "الخلق" و "المصير"، وهو الذي نصطلح عليه بالعقيدة، ويعدُّ مكوّنًا أساسيًّا في هويّتنا الفرديّة والجماعيّة.
أما مفهوم "المقدّس" الذي يرتبط بهذا المعتقد، فهو نابع من الإيمان بأنّ كلّ ما يقدّمه من تصوّر عن الإله الخالق، والحياة بعد الموت، وجدليّة الخير والشر، هو حقيقة مطلقة منيعة عن الفهم والإدراك وليس بالإمكان معرفتها والوصول إليها. بعد ذلك يصبح مصيرنا معلّقًا بمدى التزامنا بأسلوب الحياة الذي تحدّده هذه المعتقدات، أو بمعنى آخر بمدى تطبيقنا للأحكام والقيَم والتعاليم المرتبطة بها. وهنا تكمن أهمّيّة المعتقد إذ يجعلك تلتزم وتتمسّك بهذه التعاليم وبهذه القيَم مُقابل حياة مليئة بالنِّعَم تنتظرك في الحياة الأخرى. وطبعًا سيكون مصير المخالفين والمعرضين حياة كلّها شقاءٌ وندم.
وهنا يتبادر إلى ذهننا مرّة أخرى سؤال جديد: إذا كان الهدف من وراء الأديان كلّها هو إيجاد نظام مجتمعي عادل يلبّي حاجيات المرء الروحانيّة ويضمن السِّلم الاجتماعي ويحقّق المصلحة العامّة، فلماذا هذا التحامل المتصاعد على الأديان بوصفها أنّها "أفيون الشعوب" وسبب النزاعات والحروب؟
الجواب الوحيد الذي أجده منطقيًّا هو فقدانها لخاصيّة التطوّر والنموّ الملازمتين للجنس البشري. فالدِّين، بوصفه نظامًا مجتمعيًّا متكاملًا، يشكّل في بداياته نقلة نوعيّة في أسلوب عيش المجتمع الذي يظهر فيه. وغالبًا ما يكون هذا التغيير حادًّا وعميقًا لدرجةٍ تجعلُ تقبُّله ليس بالأمر الهيّن. وحين يبدأ الناس تباعًا بالانضمام إلى الدِّين الجديد، يتكوّن مجتمع حديث يتميّز عن سابقيه بمعاييره المعاصرة وبقوّة الدافع والمحفّز المنبعثة من حداثة الإيمان وتَوقُّده. ثم يمرّ الزمن وتتقادم القيَم ويصبح في الالتزام بالتعاليم والأحكام مشقّة كبيرة، وتتسبّب المتطلّبات والاحتياجات المتجدّدة في تشعّب النظام الأصليّ وظهور فروع ومذاهب كثيرة. وهكذا، يفقد الدِّين قوّته المحرّكة ويفقد معه المجتمع بريقه وتوهّجه، ولا يبقى من التديُّن سوى مظاهره، ومن الدِّين سوى رموزه الدالّة على الهويّة.
لكن، إذا نظرنا إلى كلّ هذه الأديان الموجودة على أنّها حقيقة واحدة ودين واحد يمرّ بمراحل مختلفة من التطوّر، ويتغيّر بتغيّر المكان والزمان ليتوافق وعقول الناس وقدرة إدراكهم، ويتماشى ومقتضيات العصر وحاجياته، سيصبح الأمر مختلفًا تمامًا، وسنفهم أنّ أساس المشكل ليس في الدِّين وإنّما في رفض التطوّر المرافق له. الأمر شبيه إلى حدٍّ ما بالنظام التعليمي والتربوي الذي نتّبعه في حياتنا، فحجم المعلومة وشرحها يختلفان باختلاف سنِّ المتلقّي ومراحله العمريّة.
جرّب، مثلًا، أن تخبر شابًّا ناشئًا بمدى خطورة وضع أصبعه أو أيّ شيء يمسك به في مصدر التيار الكهربائي بدعوى وجود وحش خرافي أو "بُبُّع" قد يلتهمه. سيُعرض عنك بلا شكّ لأنك تكون بذلك قد قلَّلت من شأنه ومدى قدرته على الفهم والإدراك. الحيلة نفسها سوف تنطلي على طفل صغير وتدرأ عنه الخطر بسبب الخوف الذي سيتملّكه. والأكيد في حالة الطفل هو أنّ شرحًا مستفيضًا لماهيّة التيار الكهربائي وما ينتج عنه من أضرار لن تكون كافية لمنعه من المحاولة، فهو من جهة لن يستوعب هذا الشرح ومن جهة أخرى لن يكون أمامه رادع يمنعه من ارتكاب هذا الفعل.
وبما أن البشريّة هي أيضًا تسير في درب التطوّر والنموّ، وتزداد قدرتها على الفهم والإدراك من حقبة لأخرى ومن زمن لآخر، كان لا بُدَّ "للمحتوى الديني" أن يكون مسايرًا لهذا التطوّر. لكن، في كل مرة كان يَرفُض فيها فريق من الناس قبول التغيير والتطوّر، ينقسم المجتمع إلى فريقين: "مؤمنين وكفّار". ويُكوّن "المؤمنون" مجتمعًا جديدًا بأسلوب عيش مختلف يساير العصر، وبالتالي يساعد على التقدّم والازدهار. وهكذا استمرّ الأمر على المنوال نفسه من مرحلة إلى أخرى، إلى أن تعدّدت المجتمعات وتنوّعت الثقافات. وغالبًا ما كان ينفرد المجتمع الأكثر حداثة بقيادة قاطرة الحضارة الإنسانيّة.
لكنّ السؤال الذي ظلَّ يحيّرني حقًّا هو متى ظهر أوّل دين، سواء اعتبرناه سماويًّا أو وضعيًّا؟ أو بمعنى آخر في أيّ مرحلة من مراحل تطوّر الإنسانيّة ظهرت الحاجة إلى الاعتقاد والعبادة؟ أم أنّ الأمر فطريٌّ وقد لازمنا منذ الولادة؟
هذا سؤال يجعلنا نغوص في تاريخ الأجيال بحثًا عن إجابة ما، والتاريخ بحر عميق ليس له قرار. فهنالك فترة من تاريخنا لم تكن الكتابة موجودة، وحتّى بعد أن وُجدت ظلّت معارف المؤرّخين محدودة، ولم يكن من السّهل بمكان الوصول إلى المعلومة. ولا ننسى أيضًا أنّه فيما مضى كان التاريخ يكتبه المنتصرون، وأن جزءًا مهمًّا من هذا التاريخ مصدره الدِّين نفسه ولا يُصدِّقه إلا المؤمنون. فما هي حقيقة الدِّين يا ترى إذا فقدنا الإيمان؟ ومن يدلُّنا على تاريخنا المشترك إذا استثنينا ما روته لنا الأديان؟
من الناحية العلميّة نحن ندرك أنّنا نتوفّر على ذاكرة جينيّة تعود لملايين السنين وأنّنا تعرّضنا لطفرات متعاقبة سمحت بتطوّرنا وارتقائنا. ومع ذلك نبقى عاجزين عن إدراك البداية والنهاية، فكلّما اقتربنا من البداية تبيّن لنا أنّها مجرّد بداية حقبة، وكلّما ظننّا أنّها النهاية اكتشفنا أنّها فقط نهاية مرحلة.
فكيف ظهر الكون ونشأت الحياة على الأرض، ومتى خُلق الإنسان وكيف تطور، وكيف ستكون النهاية إن كانت هنالك نهاية؟؟ ... كلّها فرضيّات اختلط فيها البحث العلمي بالموروث الثقافي والديني. والواضح أنّ معرفتنا ستبقى نسبيّة ما دامت الحقيقة التي نبحث عنها مطلقة. وبالنسبة لظهور الأديان، سنجد أنّ فكرة العبادة والاعتقاد قديمة قدم التاريخ ويمكن أن تكون كذلك من ضمن الأشياء التي يصعب تحديد بداياتها. وربّما هي غريزة إنسانيّة مرتبطة بالعقل البشري الذي يبحث عن الفهم والإدراك منذ طفولته، ويحتاج إلى جواب عن كلّ سؤال يخطر بباله.
ولكن، بصفة عامة، من بين هذه الأديان الموجودة حاليًّا سنجد أنّ أقدمها لا يشمله هذا التصنيف السماوي. يعني أنّ هذه الأديان هي من اختراع الإنسان قبل نزول الأديان السماويّة. فمن أين له، أي الإنسان، بهذه الفكرة العبقريّة التي سبقت الوحي والنبوّة؟ وهل يمكن للإنسان أن يخترع شيئًا من عدم ثم يأتي به الوحي بعد ذلك منزّلًا من السماء؟ هل يستقيم هذا الأمر؟ المقصود هو إمّا أنّ هذه الأديان، بلا استثناء، أرضيّة وضعيّة من صنع الإنسان أو أنّها جميعُها سماويّة من عند الله، وبالتالي فإنّ دين الله واحد.
كما أنّنا حين نتأمّل في معظم الأديان سنجدها تتشابه في كثير من الأشياء. فهي تتمحور حول شخصيّة عظيمة تركت منهاجًا وقدوة بالقول والفعل، اتّبعه في البداية عدد قليل من الناس أغلبهم من المستضعفين، وكوّنوا فيما بعد مجتمعًا مترابطًا ذا هويّة موحَّدة يزداد قوّة وعظمة مع مرور الوقت، وبذلك سمح بتطوّر الفكر والابتكار والهندسة والمعمار. وحتى تحافظ هذه المجتمعات الناشئة على منهاجها الذي تقتدي به كان عليها حفظه وتدوينه ولذلك ظهر "الكتاب". وهنا يبرز الاختلاف المرتبط بوسائل الحفظ والتدوين بين الأديان القديمة التي افتقدت وسائل الكتابة واعتمدت على الحفظ المنقول، فكان من الطبيعي أن يختلط الأصل بما أضافه"المجتهدون"، وتلك التي عاصرت ظهور الخطّ والكتابة واستطاعت تدوين كتابها في حينه، ورغم ذلك اختلفت في فهم المكتوب، فانقسمت فرقًا وشيعًا وأسّست طُرقًا ومذاهبَ مختلفة.
وممّا لا شكّ فيه أن تباعد المجتمعات عن بعضها البعض، وجهلها أحيانًا حتّى بتواجدها معًا على كوكب واحد، قد ساهم في تعميق هذا الاختلاف والتنوّع. اليوم، أصبحت هذه الإشكاليّة أكثر تعقيدًا، فالمجتمعات صارت متقاربة بل ومختلطة، والتنوّع أصبح عائقًا أمام التعايش بسبب التطرّف والتعصّب والعنصريّة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تأسّست أنظمة إنسانيّة حديثة تعدُّ أكثر تطوّرًا من الأنظمة الدينيّة السابقة من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. وبالنسبة للقيَم فقد أخذت منحى عالميًّا، وباتت أكثر إحقاقًا للعدل والمساواة في ملاءمتها لحاجات الإنسان والمجتمع ممّا أتت به الأديان قديمًا. لذلك، سنجد بأنّ عددًا من المجتمعات الدينيّة أصبحت تستغني عن الجانب السياسي والاجتماعي في معتقداتها، أي كلّ ما يتعلّق بالأحكام والمعاملات، مقابل النظام الديمقراطي المعاصر وقيَم المواطنة والعالميّة والتعايش وحقوق الإنسان. لكنّها، في المقابل، لا تزال ولو نسبيًّا متمسّكة ببعض مظاهر التديُّن المتعلّقة خصوصًا بالطقوس والعبادات وكلّ ما يدلُّ على الهويّة الدينيّة من ممارسات فرديّة وجماعيّة لا تؤثّر بتاتًا في الالتزام بالقيَم، فهي لم تَعُد مرتبطة بها. لكن، من جهة أخرى، نجدُ أنّ هذا النظام العالمي الجديد في صيغته الحاليّة، على الرغم من حداثته وقيَمه المعاصرة، لا يُجيب عن تساؤلاتنا الوجوديّة، ولا تلوح في الأفق القريب أيّة إمكانيّة علميّة لفهم الكون ونظامه وماهيّة الإنسان والهدف من وجوده. كما أنّه يُغَيّب الجانب الروحاني الذي يُعطينا الدافع للالتزام بالقيَم، والقدرة على مواجهة المحن، والشعور بالرضى والسعادة، والرغبة في الحياة والاستمرار. ولذلك أعتقد بأنّ الإنسانيّة اليوم ليست في حاجة فقط إلى دين جديد، بل هي في أمسّ الحاجة إلى ما يمكن اعتباره رُؤيةً جديدة لمفهوم الدين.